
محنة ابن رشد

وقعت محنة ابن رشد سنة 1195 في حقبة ما قبل الحداثة على خطّ تاريخي يمتدّ من إدانة سقراط سنة 399 ق.م. (بتهمة التجديف على آلهة المدينة وإفساد الشباب) إلى إدانة غاليلي سنة 1633 (من قِبل محاكم التفتيش التي اتهمته بالهرطقة لأنّه ناصر نظرية كوبرنيكوس عن مركزية الشمس). أمّا تهمة ابن رشد، كما هو مذكور في نص المنشور الذي تلا المحاكمة أو في سرديات المعاصرين له، فتتعلق هي أيضاً بالمسّ من دائرة المقدّس إمّا في شكله الديني، (حيث يُذكَر أنّه ضمّن أحد شروحه لأرسطو جملة تقول، «فقد ظهر أنّ الزهرة أحد الآلهة»)، أو في شكله السياسي (أنّه في شرح كتاب الحيوان لأرسطو قال عند ذكر الزرافة «وقد رأيتها عند ملك البربر» دون التفات منه إلى عادة الكتاب في تقريظ ملوك الوقت). ربما لا يخلو من دلالة أنّ هذه محاكمات رسميّة نعني تمّت تحت لواء السلطة الحاكمة، تلك التي تملك سياسة الحقيقة في زمانها، ولكن أيضاً أنّها موجّهة ضدّ شيوخ سبعينيين وليس ضدّ فتيان طائشين، ومن ثمّ هي خالية من أيّ مقصد تأديبي أو تربوي. إنّها إدانات مقصودة من أعلى هرم رمزي في ثقافة أو في عصر ما. وذلك يعني أنّها محاكمات بلا أفق أو لا تقبل أيّ نوع من التسوية، من فرط أنّها ناتجة عن تصادم بين سياستين للحقيقة، وليس عن مجرّد وشاية بين متنافسين داخل مدينة أو بلاط أو كنيسة.
المحنة في السرديات
إنّ محنة ابن رشد هي بالأساس، ومهما اختلفت سرديات المعاصرين لها، هي محنة فيلسوف وإن كان قد شاركه فيها من لم يكن من الفلاسفة، بل كان من الفقهاء وحتى من الشعراء. وحسب ابن أبي أصيبعة (ت. 1270) أنّ المنصور، «ملك البربر» أو كما صحّح ذلك ابن رشد «ملك البرّين»، قد «نقم» على ابن رشد مع «جماعة أخر من الفضلاء الأعيان.. وأظهر أنّه فعل ذلك بهم بسبب ما يدّعى فيهم أنّهم مشتغلون بالحكمة وعلوم الأوائل». والفلسفة، هي كما تفهم نفسها منذ سقراط، دعوة إلى «العناية بالنفس» وهذا مطلب عزيز لا يتسنّى لأحد إلاّ إذا «عرف نفسه بنفسه». إنّ عنصر الخصومة مع فيلسوف هو واضح تماماً: إنّه يتعلق بمستوى المسؤولية الوجودية حول ذاته. وما كان يزعج الفقهاء في أيّ وقت وتحت أيّ اسم، ليس الإلحاد بل تحرير علاقة المؤمنين بأنفسهم. ولا يكون التفكير حقيقياً إلاّ بقدر ما يتعلق بقصد واحد: تحرير علاقة الناس بأنفسهم. وبالتالي لم يكن ممكناً تفادي محنة ابن رشد. إذْ لا يمكن حلّ مشكلة دينية أو سياسية بواسطة تسوية منطقية أو لغوية.
كان الجوهر الثوري للدين التوحيدي هو نزع الألوهة عن العالم وتحويله إلى مجال تسخير للبشر. هذا انتصاره على الوثنية. وهو قد نجح في ذلك لأنّه جعل للمؤمنين به مجالاً جديداً تماماً للإرادة هو مجال التعالي: إنّ البشر الذين يؤمنون بإله خالق، خلق العالمين من عدم، تترسخ حريّتهم الجذرية تجاه بقية الكائنات من حولهم لأنّها مجرّد آيات على الخالق الذي يؤمنون بوجوده. وحسب ابن رشد إنّ الشريعة لم تأمر بأكثر من تدبّر هذا البعد الأخلاقي الرائع، نعني التكريم الذي نالوه سلفاً بموجب أنّهم مدعوّون إلى تحمّل أمانة الاستخلاف على العالم من حولهم، وليس من وسيلة مناسبة لأداء هذا التدبّر وفهم كنه هذا التكريم مثل استعمال العقل، أي الاعتبار. وهو تعبير قرآني مهيب.
بين «الاعتبار» و«التكليف»
إلاّ أنّ هذا الوضع الأصلي للتكريم قد طمسه بعض الفقهاء وتحوّل الدين إلى تجارة سياسية لا يحتاج فيها المؤمن إلى عقله بل فقط إلى طاعته. وهنا نفهم مغزى تشبّث ابن رشد بالفلسفة: فإنّ الجوهر الثوري في الفلسفة هو نزع القداسة عن الدين وتحويله إلى مجال تأويلي مفتوح أمام العقول التي تتدبّر معانيه دون وجل أو خوف. إنّ الفلسفة هي فن الاستغناء عن القداسة في فهم مقاصد النص: لا يحتاج العقل إلى أيّ نوع من التقديس حتى يفهم! ولأنّه لا يمكن محاكمة العقل إلاّ بسلطة تتعالى عليه لجأ الفقهاء إلى خلق هالة تقديس غريبة عن الدين في أوّل أمره بوصفه في جوهره دعوة إلى التدبّر والاعتبار في الآيات وفي أنفسنا.
كان ابن رشد درساً أكثر منه نظريّة: هو درس في تشخيص الإشكال الذي يرهق العلاقة بين العقل والتعالي في عصر الملة، والذي مازال مستمرّاً إلى اليوم. ومحاكمة العقل هي مقام افتضاح التصادم السياسي على أرضية الملة بين الفلسفة والفقه، وهو سياسي فقط لأنّه في سرّه تصادر بين نمطين من «العقلنة»: بين عقلانية «الاعتبار» وعقلانية «التكليف»، وليس كما يُقال بين «العقل» و«النقل». أمّا رهان هذا النزاع فهو السؤال عمّن يحقّ له السيطرة على مجال التعالي لأنّه هو المضمار الذي تجري فيه المعركة بين مؤسسة الحقيقة وتجارب الحرية في كل عصر.
#نقاش_دوت_نت


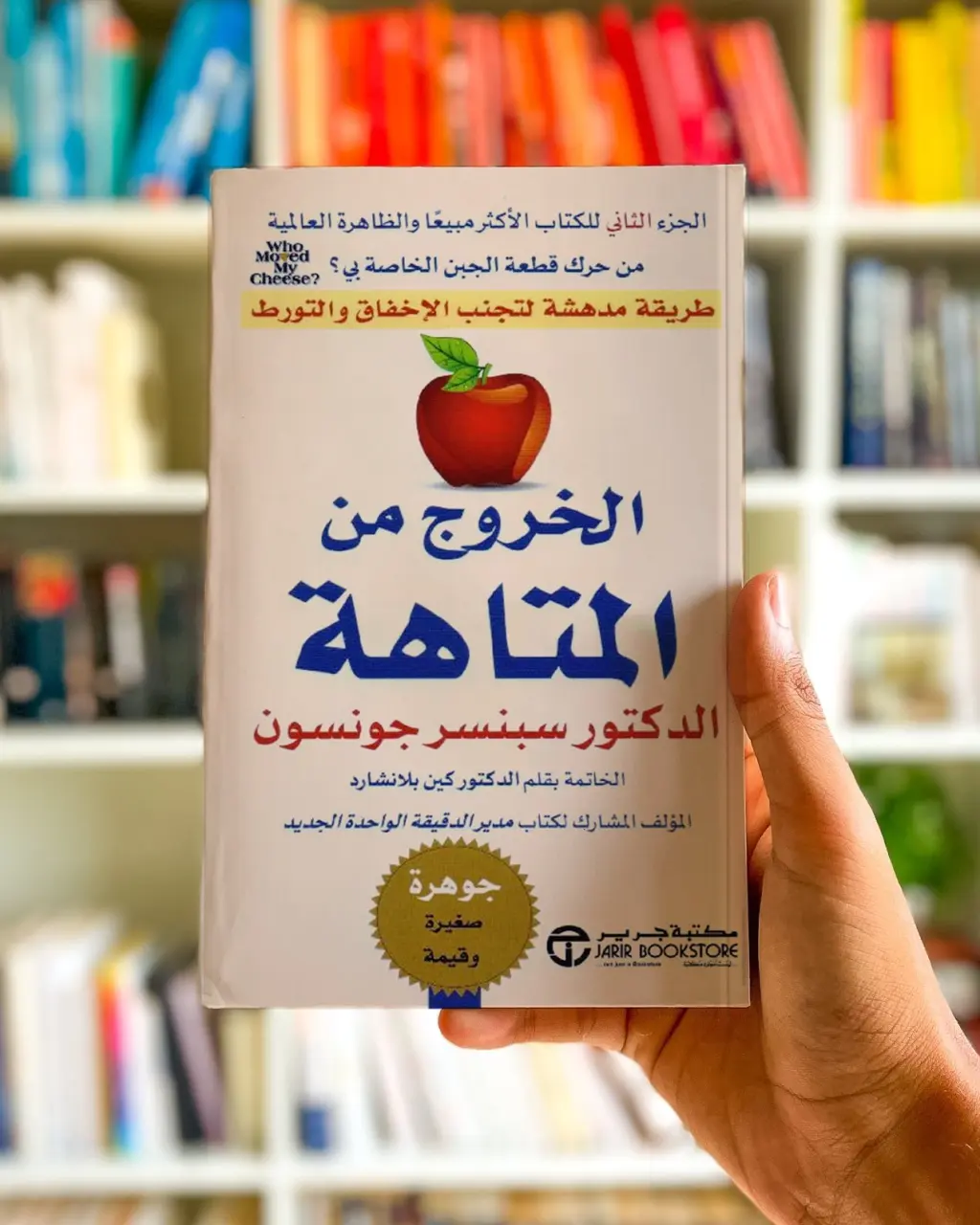





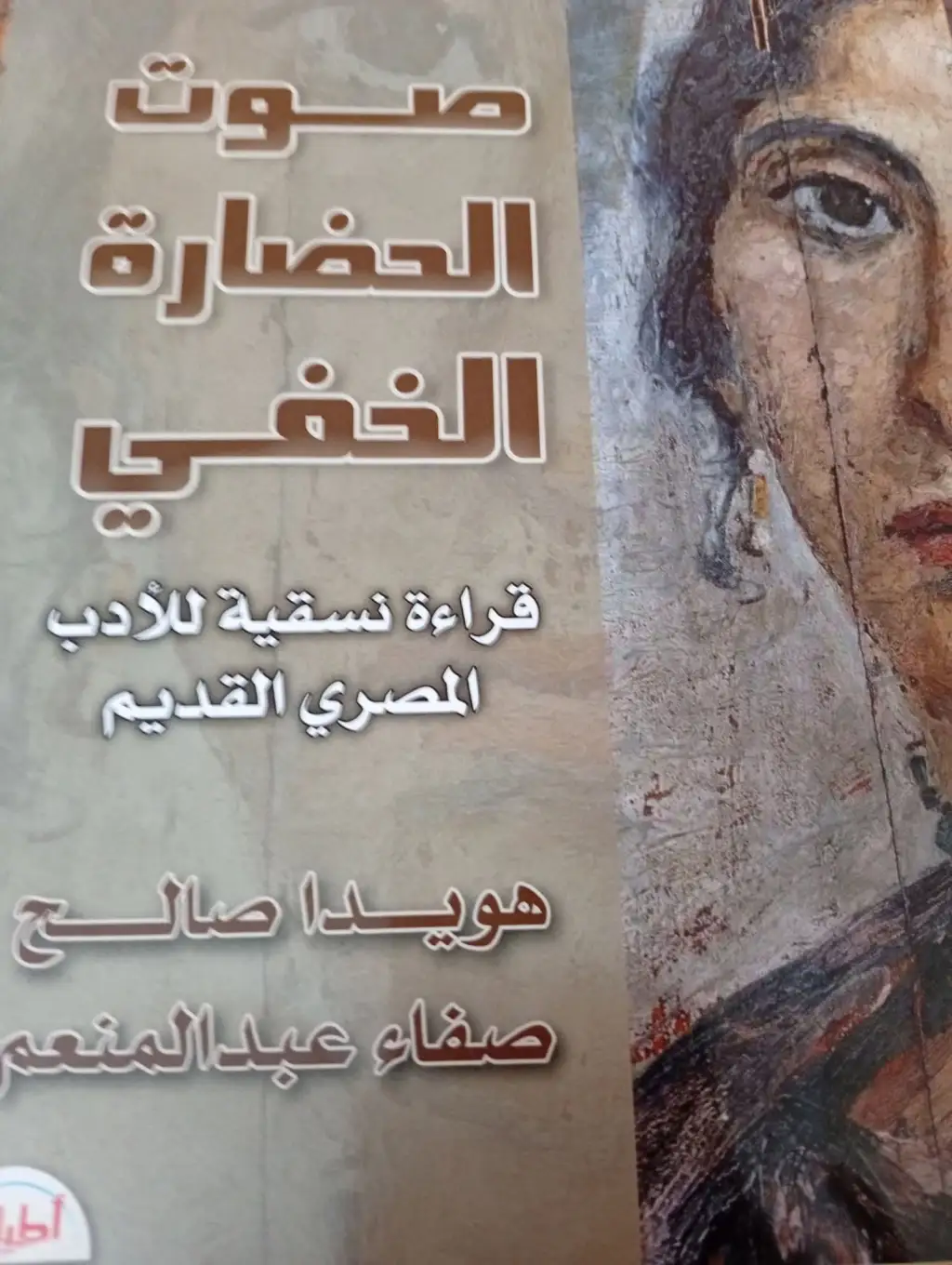







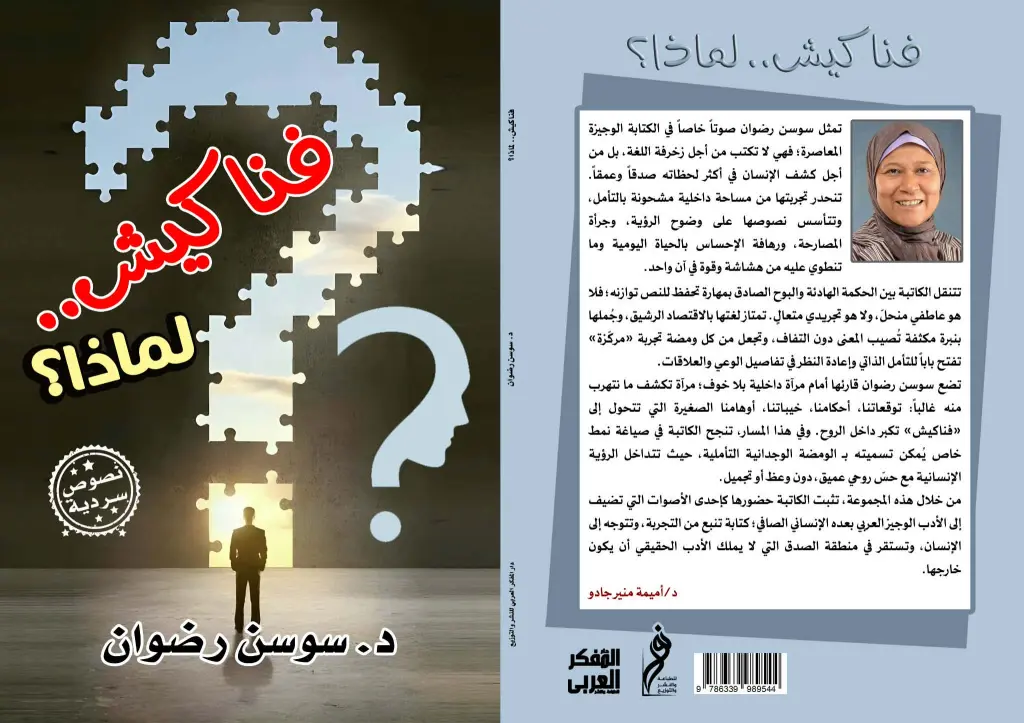





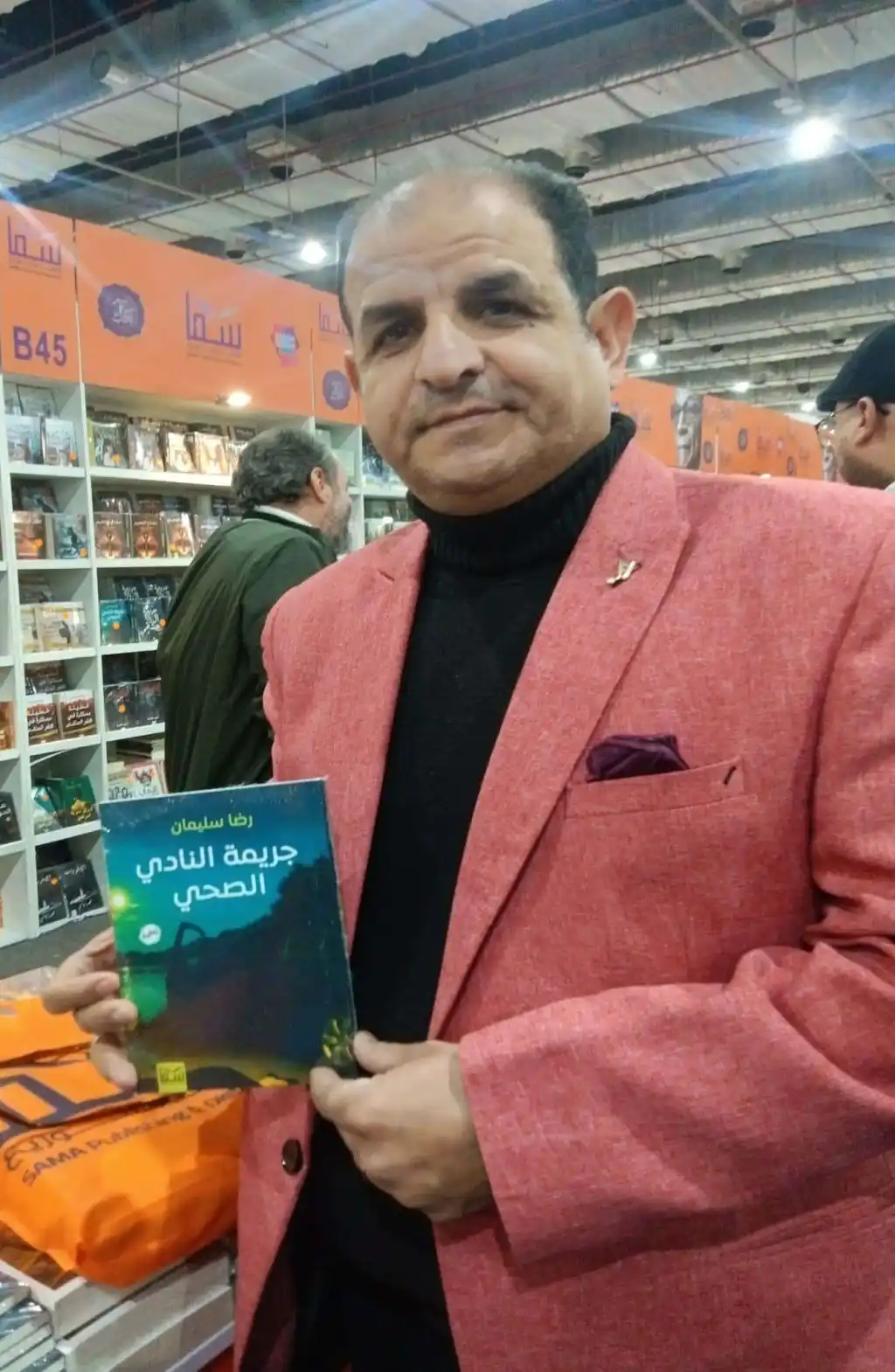
التعليقات
أضف تعليقك