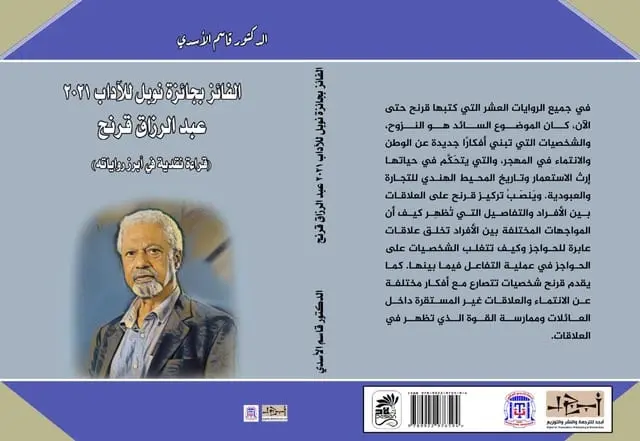
هليوبوليس والمتحف الإسلامي: رؤيتان متضادتان للعمارة والهوية

حلَّ مؤخرًا بالمنتدى العالمي للغة العربية، الذي يديره باقتدار مجلس أمناء على رأسه الأستاذة باهرة عبد اللطيف والدكتور طارق النعمان، أ.د. نزار الصيَّاد، وهو معماري ومؤرخ ومخطط عمراني مصري أمريكي، ويُعَّدُ أحد أبرز الأصوات الأكاديمية في مجال دراسات العمران وتاريخ المدن على الساحة العالمية. يشغل سيادته منصب أستاذ فخري متميز للعمارة والتخطيط والتاريخ العمراني بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، حيث ترأس سابقًا مركز دراسات الشرق الأوسط. وُلد في القاهرة عام 1956 وتخرج في جامعتها قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة ليحصل على الماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والدكتوراه من بيركلي. تتركز أبحاثه وكتاباته على تاريخ المدن، بخاصة في العالم الإسلامي، والعلاقة المعقدة بين العمارة والهوية تحت تأثير الاستعمار والقومية، بالإضافة إلى دراسات مبتكرة في العمران السينمائي والتراث. له العديد من المؤلفات المرجعية الهامة، من أشهرها كتابه "القاهرة وعمرانها: تواريخ وحكام وأماكن"، و"مدن وخلفاء"، مما يجعله مفكرًا فريدًا يحلل المدن ليس فقط بوصفها أشكالا مادية، بل باعتبارها ظواهر اجتماعية وثقافية وسياسية معقدة.
ألقى الدكتور الصيَّاد محاضرة رائعة جمعت بين المتعة والفائدة، طوَّف فيها بالمتابعين عبر بلدان عدة مستكشفاً تراثها المعماري وصلته بالهوية. وكان من أهم النقاط التي أثارها أن تلك العلاقة معقدة وغير مباشرة؛ فعمارة "الآخر"، وخصوصًا المستعمِر، قد يتبناها المجتمع المحلي بمرور الوقت حتى تصبح جزءاً من هويته، كما هو الحال في "قاهرة الخديوي إسماعيل" ذات الطابع الأوروبي.
وقد أثار هذا التحليل في نظري زاوية مهمة لفهم المصير النهائي لمشروع مثل مصر الجديدة (هليوبوليس). فهذا المشروع الذي بدأ كيانًا غربيًا يستهدف الأجانب ويجسد رؤية استشراقية، قد اكتسب معاني جديدة تماماً بعد جلاء المستعمر ومرور الزمن. لقد تبنى المصريون هذه الضاحية وأصبحت مبانيها، التي حملت يوماً دلالات على الانعزال الطبقي، جزءاً لا يتجزأ من النسيج العمراني القاهري وتراثه الحديث الذي يعتز به سكانه اليوم، في تحول يثبت أن الهوية ليست كياناً جامداً، بل هي قادرة على استيعاب ما كان غريباً وتطويعه ليصبح جزءاً أصيلاً منها.
ففي مطلع القرن العشرين، شهدت القاهرة مشروعين معماريين كبيرين، بديا متشابهين في استلهامهما للتراث الشرقي، لكنهما كانا متضادين في جوهرهما وأهدافهما. الأول هو ضاحية مصر الجديدة (هيليوبوليس)، التي أسستها شركة بلجيكية بقيادة البارون إمبان على أساس من رؤية استشراقية ، والثاني تمثل في مشاريع قومية كالمتحف الإسلامي ودار الكتب الخديوية، التي سعت لإحياء طراز مملوكي أصيل للتعبير عن هوية مصرية مستقلة.
كما تصف المقالة المرفقة، بزغت ضاحية مصر الجديدة بوصفها "حلم ساحر" في شرق القاهرة، وهي رؤية تعود للمطور البلجيكي البارون إمبان وشركته. لم تكن مجرد مشروع عقاري، بل كانت تجسيدًا لفكرة استشراقية عن "الشرق" — شرق منظم ونظيف ومُعد للاستهلاك الأوروبي. صُممت المدينة لتكون واحة للأجانب والأثرياء، بشوارعها الفسيحة وحدائقها الغناء ومبانيها التي مزجت بين الطراز المملوكي المستحدث وفنون المعمار الأوروبي المعاصر وخصوصا الآردكو Art Deco.
كان الهدف هو خلق "جو من سحر الشرق" Oriental exoticism دون التخلي عن وسائل الراحة الحديثة التي اعتاد عليها الأوروبيون، من كهرباء ومياه وشبكة ترام متطورة ربطت الضاحية الجديدة بقلب القاهرة. هذا الطابع الهجين كان جماليًا في المقام الأول، فهو لم ينبع من محاولة لإحياء تراث معماري محلي بقدر ما كان انتقاءً لعناصر بصرية شرقية لتصميم خلفية غريبة وجذابة. قصر البارون إمبان نفسه، بتصميمه المستوحى من المعابد الهندوسية والكمبودية، هو أبلغ دليل على هذا الولع بالغرائبية (Exoticism) أكثر من الأصالة.
وفي قلب هذه الرؤية المثالية، كان هناك واقع اجتماعي صارم. لم تكن هذه الجنة متاحة للجميع. فبينما خُصصت أرقى مناطق الضاحية للأوروبيين والنخبة، أُقيمت منطقة منفصلة للعمال المصريين والخدم، والتي عُرفت لاحقًا باسم "عزبة المسلمين". هذا الفصل العمراني لم يكن عشوائيًا، بل كان جزءًا من التصميم الأصلي، لضمان بقاء الطابع الأوروبي للضاحية نقيًا، مع إبقاء اليد العاملة المصرية قريبة لخدمة السكان، ولكن معزولة عن أحيائهم.
على النقيض تمامًا من مشروع مصر الجديدة، كانت هناك حركة معمارية أخرى تنمو في قلب القاهرة، حركة لم تكن تستهدف الأجانب، بل كانت تخاطب المصريين أنفسهم. تمثلت هذه الحركة في "الطراز المملوكي الحديث"، الذي سعى لإحياء أمجاد العمارة المملوكية بوصفه وسيلة للتعبير عن هوية وطنية وقومية صاعدة.
في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، كانت مصر تسعى لتأكيد ذاتها الثقافية في مواجهة النفوذ العثماني الذي استمر لقرون، والنفوذ الأوروبي المتزايد. وجد رواد النهضة المصرية في العصر المملوكي مصدر إلهام، ليس فقط لقوته السياسية والعسكرية، بل لثرائه الفني والمعماري. أصبح إحياء هذا الطراز بمثابة إعلان بأن لمصر هوية مستقلة، متجذرة في تاريخها الإسلامي، ومختلفة عن الطابع العثماني الذي كان يطغى على عمارة الدولة آنذاك.
وجاءت أبرز تجليات هذا التوجه في مشروعين ثقافيين رائدين: دار الكتب الخديوية (1904): أول مكتبة وطنية في العالم العربي، صُممت لتكون حصنًا للمعرفة والتراث المصري، ومتحف الفن الإسلامي (1903): الذي تأسس لحفظ وعرض روائع الفن الإسلامي في مصر عبر العصور. وجاء اختيار الطراز المملوكي الحديث لواجهة هذين المبنيين المتجاورين، بتفاصيلهما الدقيقة المستوحاة من المداخل والمشربيات والزخارف المملوكية، كان قرارًا سياسيًا وثقافيًا عميقًا. لقد كان رسالة مفادها أن هذه المؤسسات ليست مجرد مبانٍ، بل هي تجسيد للذاكرة والتراث القومي المصري.
عند المقارنة بين المشروعين، يتضح التباين الجذري في الفلسفة والهدف. فبينما كانت ضاحية مصر الجديدة مشروعًا تقوده شركة أجنبية وتستهدف الأوروبيين والنخبة، بهدف خلق نسخة مثالية ومنمقة من "الشرق" بوصفها منتجًا سياحيًا وسكنيًا فاخرًا، كانت المشاريع القومية مثل المتحف الإسلامي ودار الكتب نابعة من الدولة المصرية ونخبها الوطنية وموجهة للشعب المصري بأسره. لقد كان الهدف من المشاريع الوطنية هو تأكيد الهوية المستقلة في مواجهة الهيمنة الثقافية، وذلك عبر إحياء أصيل للتراث المعماري المملوكي. على النقيض، كانت علاقة مصر الجديدة بالتراث انتقائية، تمزج عناصر مختلفة لتحقيق أثر جمالي غريب. وأخيرًا، أدى هذا الاختلاف في الرؤية إلى أثر اجتماعي متناقض؛ ففي حين كرّست مصر الجديدة الفصل الاجتماعي والطبقي بين الأجانب والمصريين، سعت المشاريع القومية إلى بناء مؤسسات ثقافية جامعة تهدف لتعزيز الوعي القومي.
#نقاش_دوت_نت


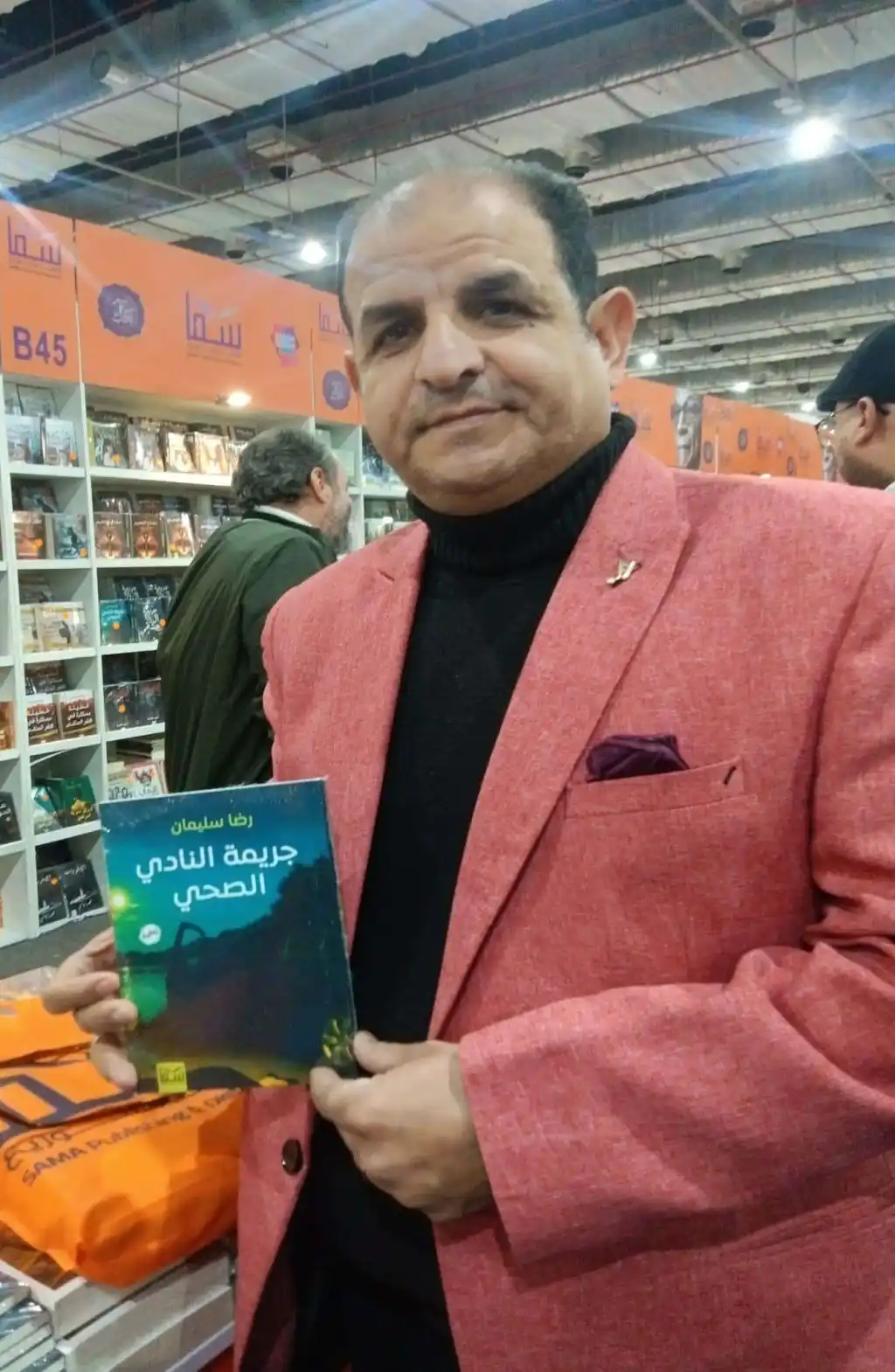
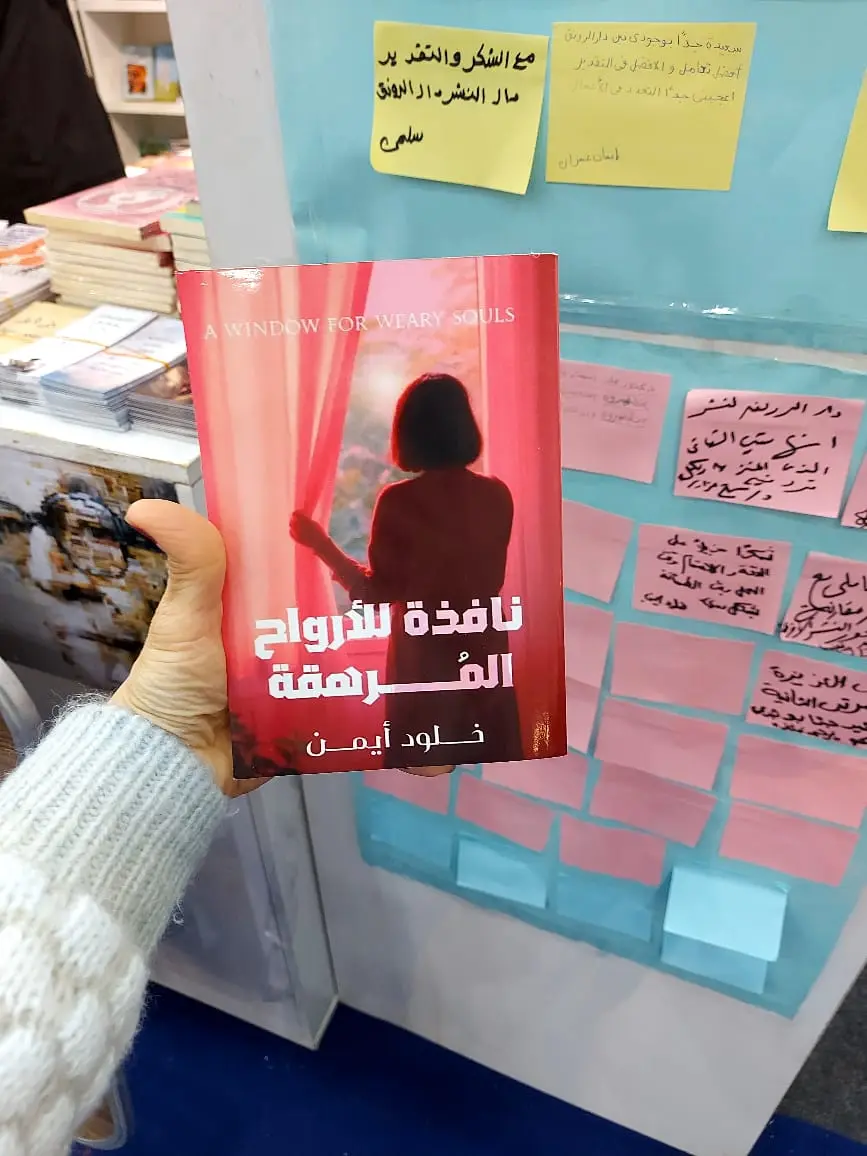











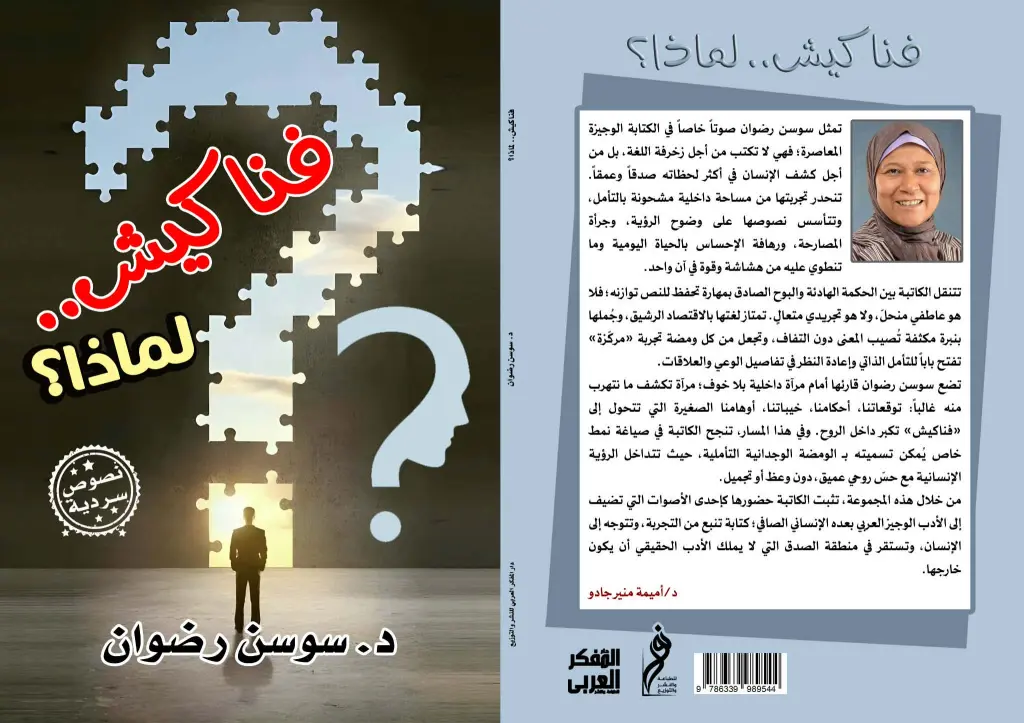





التعليقات
أضف تعليقك