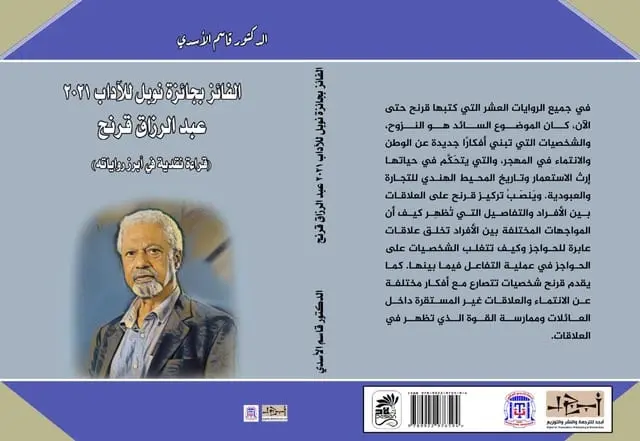
الفَرْقُ بَيْنَ التَّثَبُّتِ والتَّبَيُّنِ
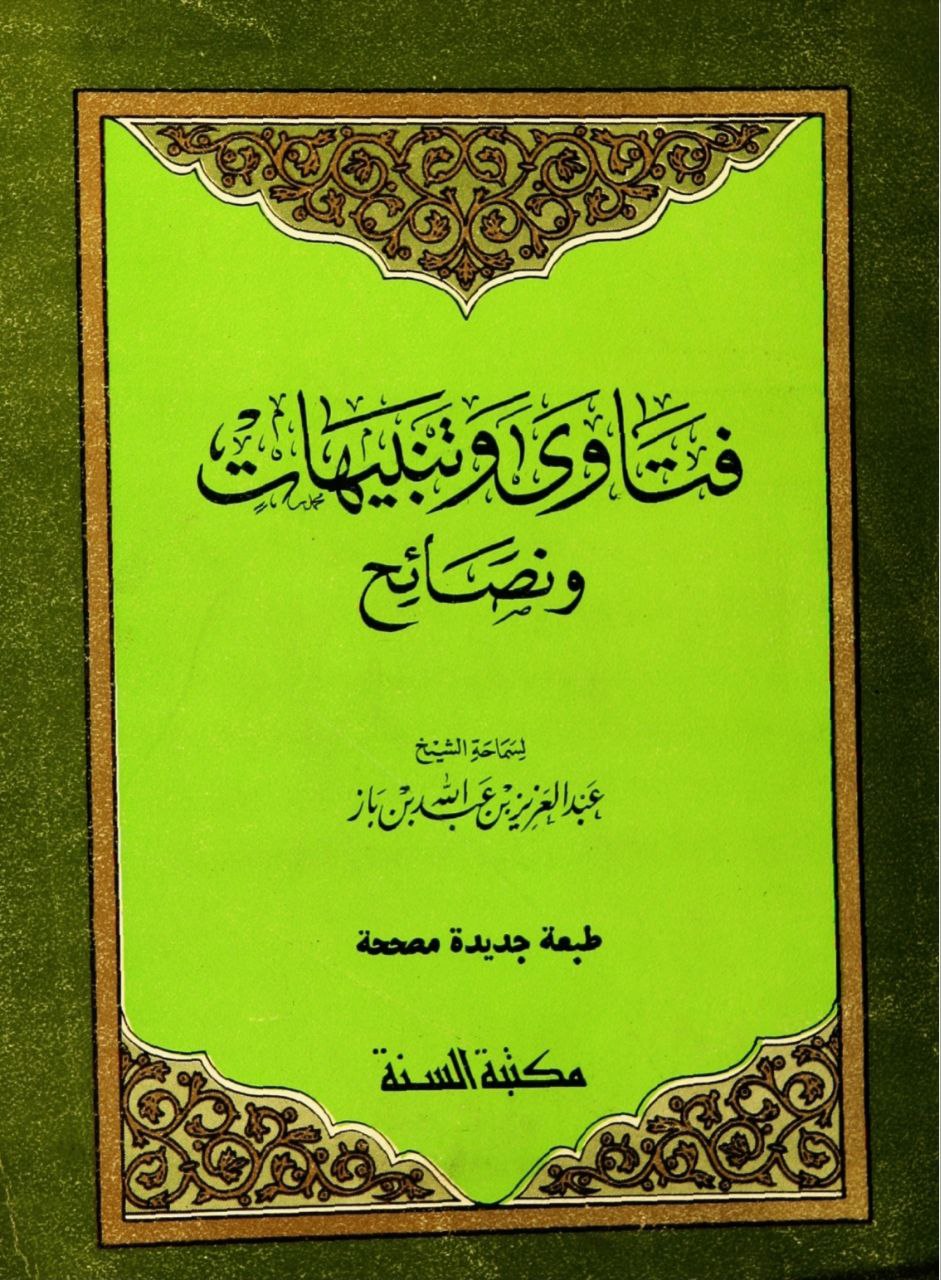
أوَّلًا : معنى التَّثَبُّتِ لُغةً واصطِلاحًا
التَّثَبُّتُ لُغةً :التَّثَبُّتُ : مَصدَرُ تَثَبَّت. والتَّثَبُّتُ : التَّأنِّي في الأمرِ وعَدَمُ الاستعجالِ فيه ، يُقالُ : تَثَبَّت في رأيِه وأمرِه : إذا لم يَعجَلْ وتأنَّى فيه ، واستَثْبَت في أمرِه : إذا شاوَر وفَحَص عنه.
التَّثَبُّتُ اصطِلاحًا :
التَّثَبُّتُ : التَّأنِّي وعَدَمُ التَّسرُّعِ في كُلِّ الأحوالِ التي يقَعُ للإنسانِ فيها نوعُ اشتباهٍ ، حتَّى يتَّضِحَ له الأمرُ ، ويتَبَيَّنَ الرُّشدَ والصَّوابَ والحقيقةَ ، وإفراغُ الجُهدِ لمعرفةِ حقيقةِ الحالِ المرادِ.
وبلَفظٍ آخَرَ : التَّأنِّي والتَّريُّثُ ، وعدَمُ التَّسرُّعِ والعَجَلةِ في كُلِّ ما يأتي الإنسانُ من أقوالٍ وأعمالٍ وإصدارِ أحكامٍ ، حتَّى يتَبَيَّنَ له الحَقُّ ، ويظهَرَ له الصَّوابُ ، ولا يندَمَ حيثُ لا ينفَعُ النَّدمُ.
وقيل : التَّثَبُّتُ : تفريغُ الوُسعِ والجُهدِ لمعرفةِ حَقيقةِ الحالِ المرادِ.
ثانيًا : الفَرْقُ بَيْنَ التَّثَبُّتِ وغيرِه من الصِّفاتِ
الفَرْقُ بَيْنَ التَّثَبُّتِ والتَّبَيُّنِ :
يرى بعضُ العُلَماءِ أنَّ التَّثَبُّتَ والتَّبَيُّنَ بمعنًى واحدٍ ، وذلك عِندَ توجيهِهم لقراءةِ {فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] ، وفَتَثَبَّتُوا. فالمتَثَبِّتُ عِندَ هؤلاء متَبَيِّنٌ ، والمتَبَيِّنُ متَثَبِّتٌ.
ويرى البعضُ أنَّ بَيْنَهما فَرقًا ؛ فقد قال أبو عليٍّ الفارسيُّ في توجيهِه للقراءةِ : (حُجَّةُ مَن قال : تَثَبَّتُوا : أنَّ التَّثَبُّتَ هو خلافُ الإقدامِ ، والمرادُ التَّأنِّي ، وخِلافُ التَّقدُّمِ ، والتَّثَبُّتُ أشَدُّ اختصاصًا بهذا الموضِعِ. وممَّا يُبَيِّنُ ذلك قولُه : {وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} [النساء: 66] أي : أشَدَّ وَقفًا لهم عمَّا وُعِظوا بألَّا يُقدِموا عليه. وممَّا يُقَوِّي ذلك قولُهم : تَثَبَّتْ في أمرِك. ولا يكادُ يُقالُ في هذا المعنى : تَبَيَّنْ.
ومن قرَأ : {فتَبَيَّنُوا} فحُجَّتُه أنَّ التَّبَيُّنَ ليس وراءَه شيءٌ ، وقد يكونُ تَبَيَّنْتُ أشَدَّ مِن تَثَبَّتُّ... ، وقد قال الأعشى :
كما راشِدٍ تَجِدَنَّ امرَأً ••
تَبَيَّنَ ثمَّ ارعوى أو قَدِمْ
فاستعمَل التَّبَيُّنَ في الموضعِ الذي يقِفُ فيه ناظِرًا في الشَّيءِ حتَّى يُقدِمَ عليه أو يرتَدِعَ عنه. فالتَّبَيُّنُ على هذا أَولى من التَّثَبُّتِ ، وقال في موضِعِ الزَّجرِ والنَّهيِ والتَّوقُّفِ :
أَزَيدَ مناةَ تُوعِدُ يا بنَ تَيمٍ ••
تَبَيَّنْ أين تاهَ بك الوعيدُ
ومِن أوجُهِ الفَرْقِ التي وردت ما قاله أبو النَّجمِ النَّسَفيُّ : {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] ، وقُرِئ {فَتَثَبَّتُوا}. التَّبَيُّنُ والاستبانةُ : التَّعرُّفُ والتَّفحُّصُ ليُعلَمَ ، والتَّثَبُّتُ والاستِثباتُ : التَّأنِّي والتَّأمُّلُ لِيَظهَرَ).
وقال الشَّوكانيُّ : (المرادُ من التَّبَيُّنِ التَّعرُّفُ والتَّفحُّصُ ، ومن التَّثَبُّتِ : الأناةُ وعَدَمُ العَجَلةِ ، والتَّبصُّرُ في الأمرِ الواقِعِ والخبَرِ الوارِدِ حتَّى يتَّضِحَ ويَظهَرَ).
وقيل : (الرَّاجِحُ أنَّ بَيْنَهما فَرقًا ، فلو لم يكُنْ بَيْنَهما فَرقٌ لَما جاءت القراءةُ الأُخرى باللَّفظِ الآخَرِ ، فهناك فرقٌ بَيْنَهما... : أنَّ التَّبَيُّنَ يكونُ بالبَحثِ في الوسائِلِ المادِّيَّةِ التي من شأنِها أن تُرى وتُبانَ ، بينما التَّثَبُّتُ يكونُ من جهةِ الأمورِ المَعنويَّةِ ، كالسَّماعِ).
الفَرْقُ بَيْنَ التَّثَبُّتِ والنَّظَرِ :
النَّظَرُ : تقليبُ البَصَرِ أو البصيرةِ لإدراكِ الشَّيءِ ورؤيتِه ، وقد يرادُ به التَّأمُّلُ والفَحصُ ، وعلى هذا فالنَّظَرُ #وسيلةٌ من وسائِلِ التَّثَبُّتِ وتحقيقِه.
الفَرْقُ بَيْنَ التَّثَبُّتِ والتَّحَرِّي :
التَّحَرِّي : طَلَبُ الشَّيءِ بغالِبِ الرَّأيِ عِندَ تعذُّرِ الوقوفِ على حقيقتِه ، وهو غيرُ الشَّكِّ والظَّنِّ ؛ فالشَّكُّ : أن يستويَ طَرَفُ العِلمِ بالشَّيءِ والجَهلِ به ، والظَّنُّ : أن يترجَّحَ أحَدُهما بغيرِ دليلٍ ، والتَّحَرِّي : أن يترجَّحَ أحَدُهما بغالِبِ الرَّأيِ ، وهو دليلٌ يُتوصَّلُ به إلى طَرَفِ العِلمِ وإن كان لا يُتوصَّلُ به إلى ما يوجِبُ حقيقةَ العِلمِ ، ومن أجْلِه سُمِّيَ تحرِّيًا.
ويظهَرُ من التَّعريفِ أنَّ التَّثَبُّتَ أقوى في الوقوفِ على الحقيقةِ من التَّحَرِّي ؛ فالتَّحَرِّي دَرَجةٌ أدنى من التَّثَبُّتِ.
ثالثًا : التَّرغيبُ في التَّثَبُّتِ والحَثُّ عليه
أ- من القُرآنِ الكريمِ
1⃣ قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6] .
أي : {يا أيُّها الذين آمنوا إن جاءَكم أيُّ فاسِقٍ} كان بأيِّ خَبَرٍ ، فتمَهَّلوا وتوَقَّفوا عن قَبولِ خَبَرِه ، حتَّى تتيقَّنوا منه ، فتتَبَيَّنوا صِدقَه أو كَذِبَه ، وتظهَرَ لكم الحقيقةُ ، {أَنْ تُصِيُبوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} أي : إنْ جاءَكم فاسِقٌ بنَبَأٍ فتَبَيَّنوا ؛ لئلَّا تُصيبوا -خطَأً وجَهلًا منكم- قومًا بُرآءَ ممَّا قُذِفوا به بسَبَبِ تصديقِكم الفاسِقَ في خَبَرِه الكاذِبِ ، {فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} أي : فتندَموا -أيها المُؤمِنون- على إصابتِكم القومَ البُرآءَ بأذًى وضَرَرٍ ؛ بسبَبِ تعَجُّلِكم في قَبوِل خَبرِ الفاسِقِ ، وتركِكم التَّبَيُّنَ والتَّثَبُّتَ.
قال الطَّبَريُّ بعدَ أن بَيَّنَ أنَّ عامَّةَ القُرَّاءِ قَرَؤوا (فتَبَيَّنُوا) ، وقرأ أهلُ المدينةِ (فتَثَبَّتُوا) ، وأنَّهما قراءتانِ معروفتانِ متقارِبتا المعنى يصيبُ القارئُ بأيَّتِهما قرأَ ، وذَكَر عدَّةَ أسبابٍ في نزولِ الآيةِ : (فتَبَيَّنوا ، بالباءِ ، #بمعنى : أمهِلوا حتَّى تَعرِفوا صِحَّتَه ، لا تَعْجَلوا بقَبولِه ، وكذلك معنى فتَثَبَّتوا).
وهذا من الآدابِ التي على أُولي الألبابِ التَّأدُّبُ بها واستعمالُها ، وهو أنَّه إذا أخبَرَهم فاسِقٌ بخبَرٍ أن يتَثَبَّتوا في خَبَرِه ، ولا يأخُذوه مجَرَّدًا ؛ فإنَّ في ذلك خطَرًا كبيرًا ، ووقوعًا في الإثمِ ؛ فإنَّ خبَرَه إذا جُعِل بمنزلةِ خَبَرِ الصَّادِقِ العَدلِ حُكِم بموجِبِ ذلك ومُقتَضاه ، فحَصَل من تَلَفِ النُّفوسِ والأموالِ بغيرِ حَقٍّ بسَبَبِ ذلك الخبرِ ما يكونُ سببًا للنَّدامةِ ، بل الواجبُ عِندَ خبرِ الفاسِقِ التَّثَبُّتُ والتَّبَيُّنُ ، فإن دلَّت الدَّلائِلُ والقرائنُ على صِدقِه عُمِل به وصُدِّق ، وإن دلَّت على كَذِبه كُذِّب ولم يُعمَلْ به.
وهذه الآيةُ الكريمةُ أصلٌ عظيمٌ في تصَرُّفاتِ وُلاةِ الأمورِ ، وفي تعامُلِ النَّاسِ بعضِهم مع بعضٍ ؛ من عَدَمِ الإصغاءِ إلى كُلِّ ما يُروى ويُخبَرُ به.
#نقاش_دوت_نت


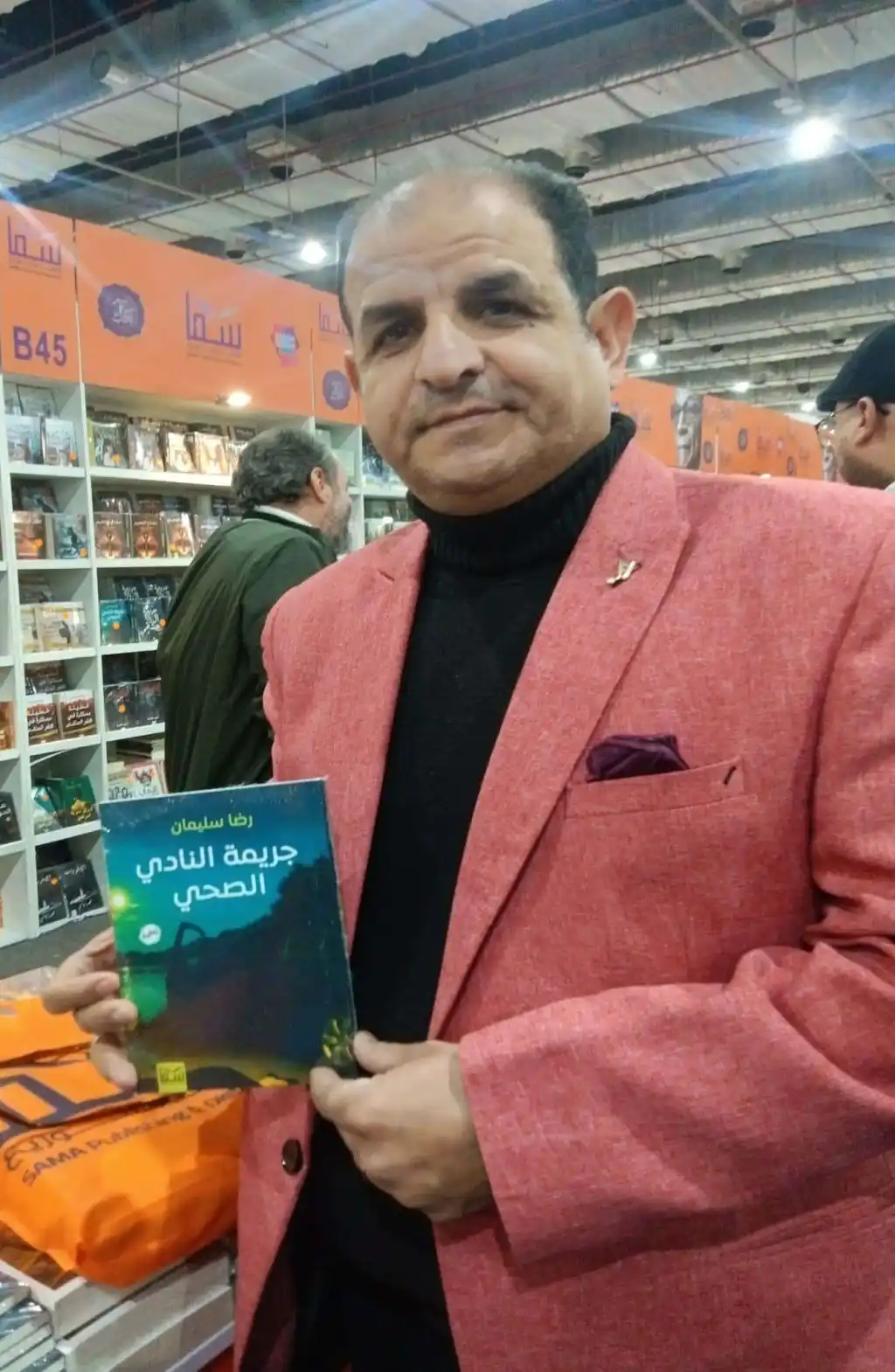
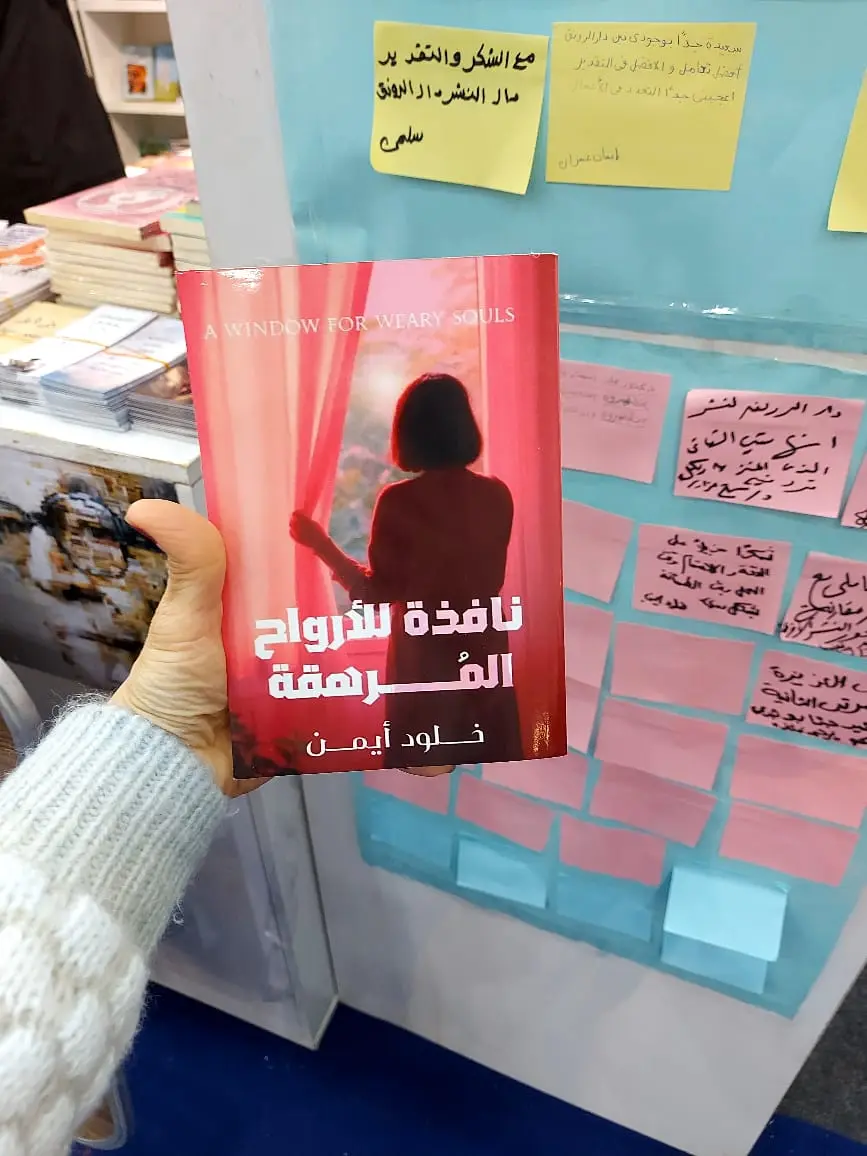











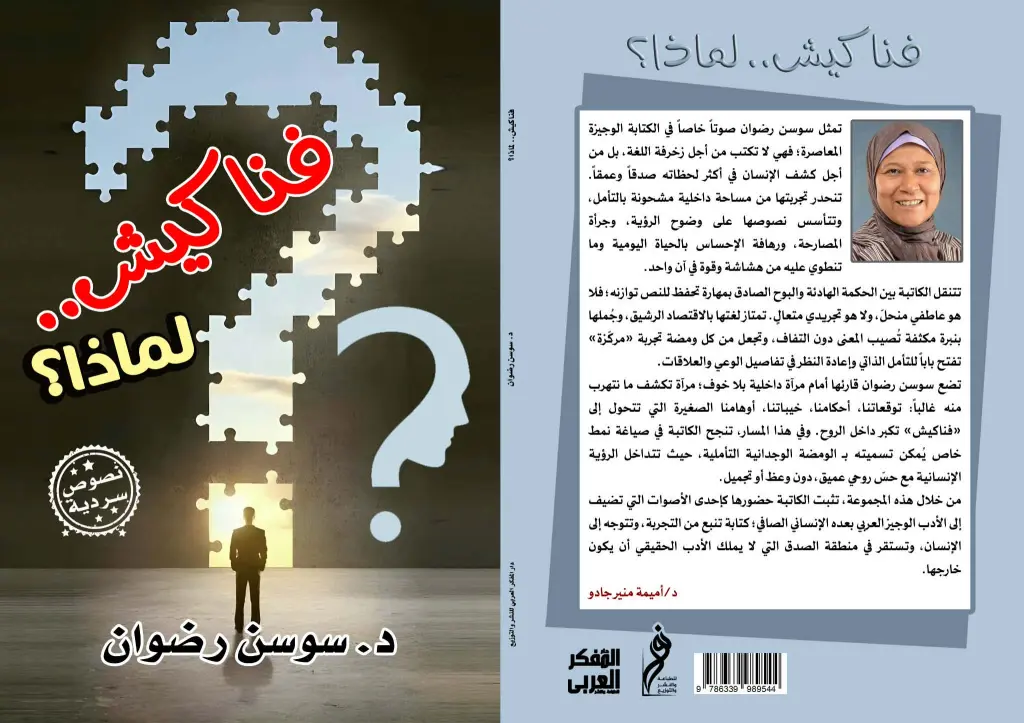





التعليقات
أضف تعليقك