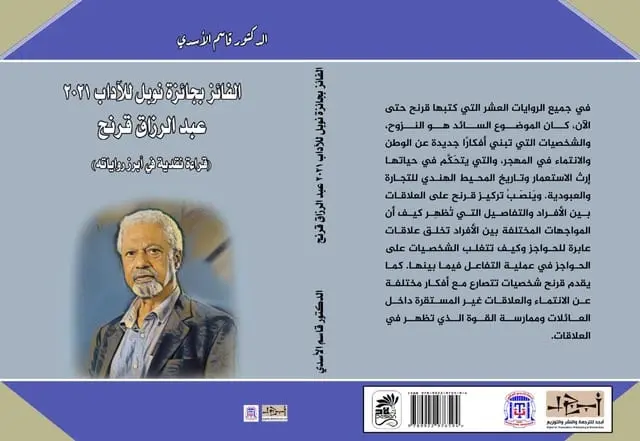
الترجمةبوصفها فعلا غير محايد: أول رسالة دكتوراه في ألسن كفر الشيخ تستكشف دور السرديات في صياغة النص

نوقشت يوم الثلاثاء الموافق 28 من أكتوبر رسالة الدكتوراة الأولى في كلية ألسن، جامعة كفر الشيخ. تقدم بها محمد سعد كامل محمد، المدرس المساعد بالقسم بإشراف الأستاذ الدكتور عادل عفيفي، والأستاذ الدكتور محمد يسري عقل.
وتشكلت لجنة المناقشة من أ.د. مصطفى رياض، و أ.د. أيمن الحلفاوي، والمشرفين.
تطرح أطروحة "(قراءة سردية في (اللا)ترجمة إلى العربية قديمًا وحديثًا)" ما يمكن تسميته "تأريخًا سرديًّا" لممارسات الترجمة في السياق العربي. وتقوم الأطروحة على حُجّةٍ مركزية مفادها أن الترجمة ليست فعلًا لغويًا مُحايدًا، بل هي، على نقيض ذلك، فعلٌ يتشكّل في جوهره بالـ"سرديات" الثقافية والأخلاقية والسياسية والدينية السائدة التي ينشط المترجمون ومجتمعاتهم في إطارها.
تستند الدراسة بأسرها إلى نظرية السرد (Narrative Theory) لدى الباحثة منى بيكر. ولتطبيق هذا الإطار المنهجي، يقترح الباحث نموذجًا تحليليًا مُحددًا ذا مستويات ثلاثة، صُمِّمَ خصيصًا لتقصّي ظواهر الترجمة. ويشتمل هذا النموذج على: الانتقائية (Selectivity)، وتتعلق بالقرارات الكُلّية (macro-level) حول ما يُختار من نصوص أو أجناس أدبية لترجمته أو استبعاده؛ والمُناصِّيَّة (Paratextuality)، وتفحص توظيف التعليقات المحيطة بالنص —كالمقدمات والحواشي والمراجعات— لتأطير الترجمة وتوجيه استقبال الجمهور لها؛ والتكييف (Adaptivity)، ويركّز على التعديلات النصّية الجزئية (micro-level)، بما في ذلك الحذف أو الإضافة أو غيرها من التغييرات التي تُجرى داخل النص المترجَم لمواءمته مع سرديات بعينها.
وقد بُنيت الأطروحة في هيئة سلسلة من دراسات الحالة التاريخية التي تُطبّق هذا النموذج الثلاثي على حِقَبٍ زمنية مختلفة. ويسبق الدراسةَ الفصلُ الأول، الذي يمهّد للمشهد النظري عبر استعراض الجدل التاريخي حول قابلية الترجمة في مقابل استعصاء الترجمة، مُدمِجًا في ذلك رؤى من الخطاب العربي القديم ونظرية الترجمة الغربية الحديثة. وتتجلى أهمية هذا التأصيل النظري في استعانة الباحث بكتابات مرجعية، كدراسة طارق شمة وماريام سلامة كار عن الخطاب العربي في الترجمة، فضلًا عن عقده صلاتٍ مبتكرة بين رواد الفكر اللغوي قديمًا وحديثًا، كالصلة التي يقيمها بين تشومسكي والشاطبي، وبين أندريه لوفيفر وابن قتيبة.
أما دراسة الحالة الرئيسية الأولى، وهي الفصل الثالث بعنوان "الجاذبية العلمية في الإسلام الكلاسيكي"، فتستخدم النموذج الثلاثي لتحليل أسباب الإقبال الشديد على ترجمة العلوم اليونانية في العصر العباسي. ويقابل هذا، على نحو مباشر، الفصلُ الخامس بعنوان "النفور الأدبي في الإسلام الكلاسيكي"، الذي يستكشف الظاهرة المرافقة، وهي: الاجتناب الواسع لترجمة الآداب الأجنبية، كالشعر والدراما اليونانيين، إذ عُدَّت إلى حد كبير عصيّة على الترجمة في الحقبة ذاتها.
ثم تعكس الأطروحة هذا البنيان ذاته في العصر الحديث، كاشفةً عن انقلابٍ تامٍ في الاتجاهات التي سادت في العصر الكلاسيكي. فالفصل الرابع، "تحوّل الاهتمام العلمي في العصر الحديث"، يناقش تراجع وتيرة الترجمة العلمية وما ارتبط بها من جدالات مصطلحية. ويعقبه الفصل السادس، "المدّ الأدبي في العصر الحديث"، الذي يحلل "التدفق الهائل" للترجمات الأدبية الأجنبية إلى العالم العربي الحديث.
وتتناول الفصول الأخيرة موضوعات متخصصة وممارسات معاصرة. فالفصل السابع يركز على "الاسترداد" (Istirdād)، وهي ممارسة متمايزة تتمثل في ترجمة دراسات الاستشراق الأوروبي —أي الأعمال المكتوبة عن العالم العربي الإسلامي— وإعادتها إلى اللغة العربية. **وتبرز قيمة هذا الفصل في استعانة الباحث بالنظرية الجديدة التي أطلقها شكري مجاهد، وهي "نظرية الاسترداد"، والتي تقضي بتأصيل الألفاظ عبر الإتيان بأصولها العربية بدلاً من ترجمتها عن المستشرقين.
أما الفصل الثامن، فيُطبّق نموذج السرد على ممارسات الترجمة الحديثة في مجالات كالسياسة، والتغطية الإخبارية، والترجمة السمعية البصرية (subtitling)، والترجمة الفورية. ويضم هذا الفصل أيضًا نتائج استبيان أُجري عبر الإنترنت مع مترجمين ممارسين.
وتُختتم الأطروحة بتلخيص النتائج التي توصلت إليها، ومناقشة حدود البحث، وتحديد مجالات للبحث المستقبلي، تليها ملاحق تشمل استبيان المترجمين وملخصًا باللغة العربية.
وقد حصل الباحث على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل رسالته مع الجامعات.


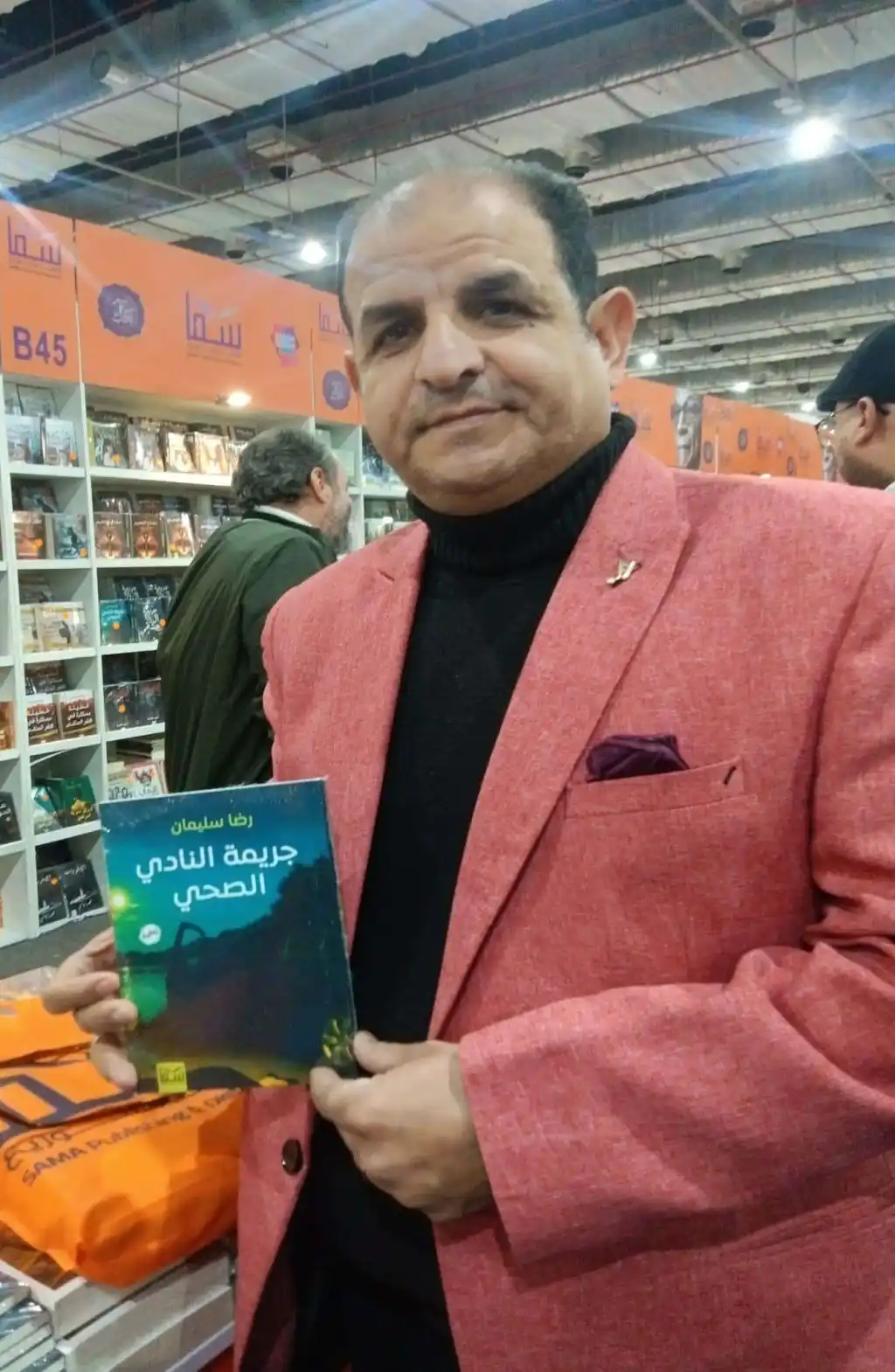
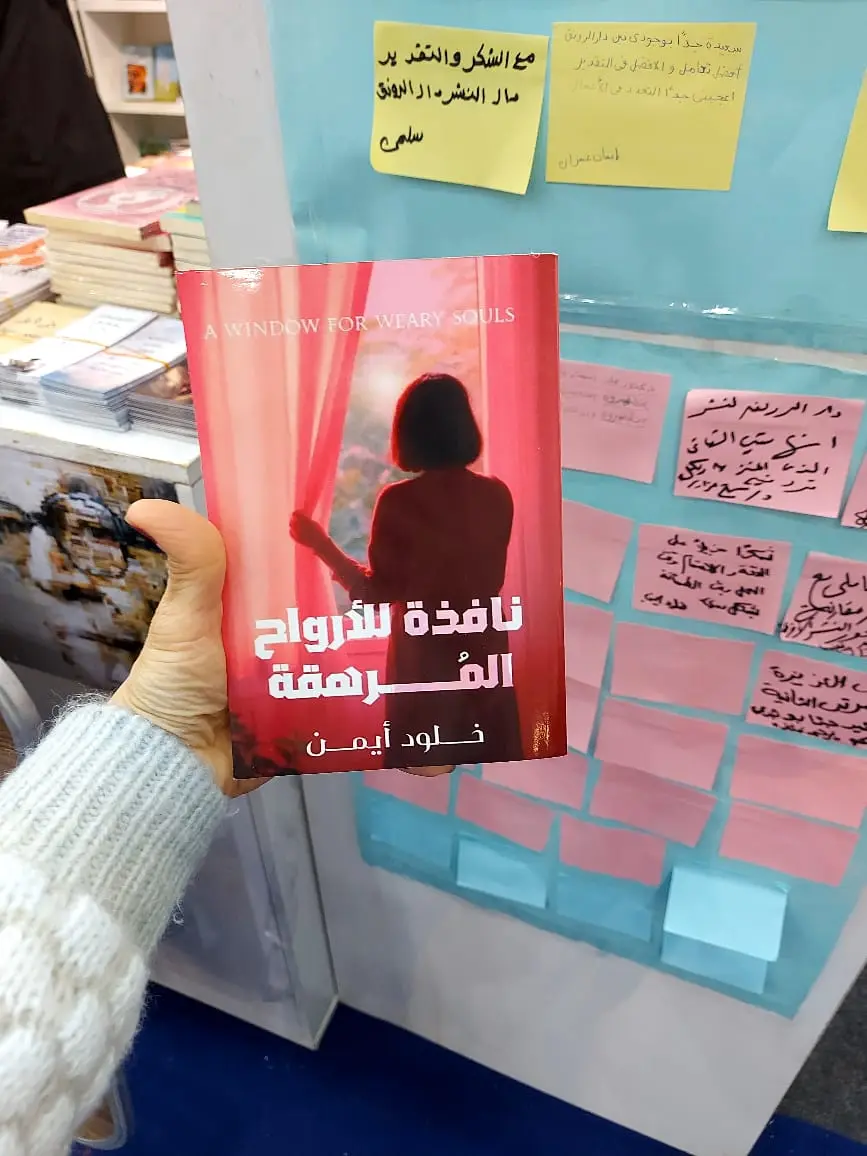











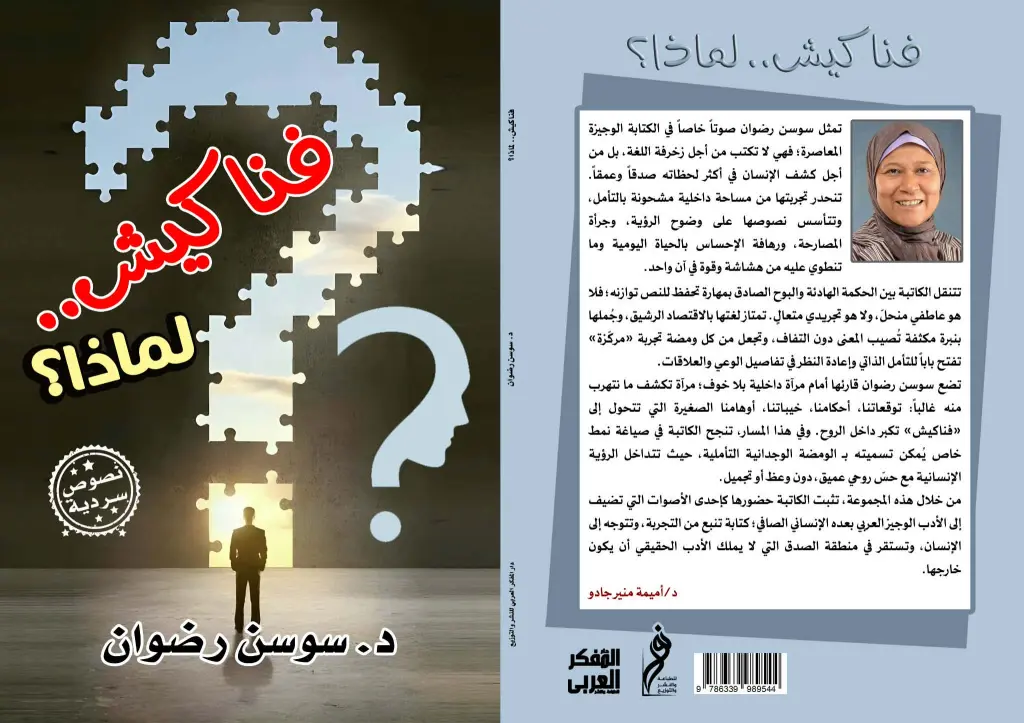





التعليقات
أضف تعليقك