
رؤية ذائقية للمجموعة القصصية "صوت من الماضي"للكاتب الصحفي حسام أبوالعلا
.jpg)
الملاحظ في أعمال الأستاذ حسام أبو العلا لها سمة مشتركة تُظهر حساسيته الإنسانية وميله الفطري على استحضار صور الفقد والألم ، لقد ظهر ذلك باختياره عناوين أعماله السابقة الذي بدا فيها الألم والإنكسار و هى " الكيس الأسود ، قلب مهزوم ، موعد للفراق ، وداع ، وأخيراً صوت من الماضي " الذي يحمل عنوانها أفقاً مزدوجاً يفتح شهية القارئ منذ البداية؛ فهو من جهة يوقظ البعد الوجداني بما يحمله من حنينٍ وذكريات ووعدٍ لم يكتمل، ومن جهة أخرى يتجاوز هذا البعد العاطفي ليطرح تساؤلات فلسفية أعمق: أهو صدى لأشخاص غابوا وما زال أثرهم يلاحقنا؟ أم هو انعكاس لذواتٍ فقدناها على الطريق ؟ أهو وعد بالاستمرار أم جرس إنذار لفقدٍ لا يُستعاد؟
هنا يبرع الكاتب في اختيار عنوان يُبقي النص مفتوحًا على التأويل، فيتلقاه القارئ البسيط كتجربة وجدانية، بينما يلتقط الناقد خلفه إشارات وجودية وفكرية أوسع.
هذا الوعي بالثنائية انعكس أيضًا على نصوص المجموعة، وهو ما يكشف أثر خلفية الكاتب الصحفية ؛ فقدّم بعض القصص بنَفَس واقعي مباشر ينقل نبض الشارع مثل " بسمة أمي ، سر المرحوم ، فاتورة الحساب ، بينما ارتقى في قصص أخرى إلى بعد فلسفي ورمزي في قصة " الجدران "، التي تفتح مجالًا خصبًا للتأمل والنقد. وبين هذين القطبين وُجدت نصوص جمعت البساطة بالعمق في آنٍ واحد، كما في " 2050 " .
بهذا المعنى يُطل لنا ذكاء الكاتب في مخاطبة أكثر من مستوى من القراء: بدءًا من القارئ العادي إلى الناقد المتخصص، دون أن يفقد النص صدقه أو روحه.
أُضيف أيضا للكاتب صفة الجرأة، بل والأمانة، في تعدد زوايا الطرح بتجربته القصصية ؛ فقد جعل المرأة بطلةً في الحضور، بينما ظلّ الرجل يطلّ كظلٍّ كاشفٍ لعيوبه. لم يتردّد في فضح خيانة بعضهم، كما في " التركة " حيث يتحوّل الزواج عند البطل إلى مهنة لإشباع الغرائز لا رباطًاً مقدسًا ؛ وواجه صورة الرجل البخيل في قصة " فاتورة الحساب" ، ذلك الذي تختزله أنانيته في حفنة نقود .
لم يتوقف عند هذا الحد، بل عرّى أيضًا نموذجًا يُحسب على رجال الدين مظهرًا لا جوهرًا، حين صوّره في قصة " الرجل المعمّم "وهو يتتبع النساء بعينيه ، كاشفًا تناقض الوعظ والسلوك .
هكذا يضع الكاتب القارئ أمام مرآة ناقدة لا تجامل أحدًا ، بل تكشف هشاشة الأقنعة التي يحتمي بها الرجال.
ولعل ما يميز الكاتب هنا أنه لم يقع في فخ الانحياز الأعمى، إذ أضاء بجرأته على عيوب بعض الرجال، في وقتٍ يتغاضى فيه كثيرون عن مواجهة أخطاء بني جنسهم، متناسين أن المرأة والرجل شريكان في الخطأ كما هما في الصواب.
من اللافت في مجموعة " صوت من الماضي " أن الأرقام لم تكن مجرد زينة شكلية، بل كان لها نصيب بارز في تشكيل العناوين نفسها، كما في قصتي " 2050 ، غرفة 177 " هذا الحضور الرقمي يفتح أفقًا إضافيًا للتحليل؛ فالأرقام في الأدب ليست محايدة، بل تحمل شحنة رمزية تتجاوز معناها الحسابي لتصبح مفاتيح لقراءة النص . فهي أحيانًا بوابة لاستشراف المستقبل وطرح الأسئلة الوجودية الكبرى كما في قصة " "2050 " ، وأحيانًا أخرى معمارًا فلسفيًا قائمًا بذاته يكشف عن ثنائية الامتحان والضعف واللاوعي كما في قصة " غرفة 177" . بذلك تتحول الأرقام إلى لغة موازية للنص، تُثري التأويل وتمنح القارئ فرصة للتنقل بين الواقعي والفلسفي في آن واحد .
في " غرفة 177 " وقف رقم " 1 " رمزًا للفردية والبداية والذات ، في مواجهة جدارٍ مزدوج مثَله الرقم " 7 " بتكراره بما يحمله من ثقل وسر الامتحان الروحي . هذه البنية تجعلنا نقرأ الرقم كرحلة وجودية تبدأ بالوحدة (1)، ثم تتكرر فيها التجربة مرتين بتكرار ( 7)، كأن الإنسان محكوم بأن يخوض الاختبار ذاته في صور متكررة مهما ظن أنه يتقدم . لكن هذه الامتحانات ليست واحدة في جوهرها ؛ فالأول تحوطه مشاعر الحب والعطاء والخوف على مَن نحب، حيث ينتهي بالبكاء على الفقد ، أما الثاني فيرتبط بالمرض لا كأداة تذكير بضعف الفرد فحسب ، بل كارتدادٍ قاسٍ على مَن كان يومًا مصدرًا للألم أو التدمير. هنا يتبدل المشهد : من مارس القسوة بالأمس يصير اليوم ضعيفًا، يستجدي العطف ممَن حطم حياتهم من قبل. وبين هذين الامتحانين نقف أمام ضمائرنا، فيما يعمل اللاوعي عمله في الخفاء؛ يخزن الأحداث ولا يفرط فيها، ثم يخرجها لاحقًا في هيئة اعتراض أو قسوة أو حتى شفقة مترددة، وكأنها انعكاسات خفية لا يمكن الانفلات منها، بل تظل جزءًا من مسارنا الداخلي .
الأستاذ حسام لم يختبر نفسه فقط في طرح الأفكار ولا طريقة السرد بل أختبر قدرتنا على التلقي ، ففي قصة 2050 اختبرقدرتنا ، هل سنقف عند حدود السرد، أم سنتوغّل في الفجوات التي تركها ؟ ، فهى نصّ تجاوز بالفعل حدود الحكاية البسيطة، وتمتّع بعمق فلسفي يكشف عن ظلال رؤيته .
لقد بدأ القصة بمفارقة فلسفية تكمن في التناقض بين الانهيار والثبات في كل من "السقف المتساقط طلاؤه" و"الأسفلت". ربما يكون هذا التناقض تشبيهًا للفارق بين الفكرة التي تنهار والتجربة التي تستمر رغم كل شيء. ومن خلال الوصف الدقيق للإضاءة الضئيلة التي تأتي من نافذة صغيرة في أعلى الجدار، المطلة على الأسفلت، ندرك أن البطل يعيش في بدروم. فهو لم يُصرَّح بذلك مباشرة، لكنه ترك المجال لخيال القارئ كي يتخيل عتمة المكان ورائحة الجدران المتساقط طلاؤها بفعل الرطوبة. بهذا الوصف أحسسنا بالبرودة التي تسري في الجسد، وكأننا لا نقرأ كلمات بل نحياها.
لم يكتفِ الكاتب بالوصف بل بالغ في توظيف التفاصيل الرمزية: الباب الذي تتكدس خلفه الأوراق بدا وكأنه "حقيقة مؤجلة". فالباب رمز العبور واتخاذ القرار ، وربما يعني الانتقال من مرحلة المعاناة الصامتة إلى مرحلة السعي، أما الأوراق فهي الحقائق التي لم تُكشف بعد .
لقد وفق الكاتب حين جعل البطل يتجه نحو زر الكهرباء لتبدّد الإضاءة عتمة الغرفة، إذ وضعنا أمام مفارقة جدلية: هل تبقى الحقيقة مخفية إلى أن يُفعَّل الوعي؟ أم أن الواقع موجود أصلًا، لكنه ينتظر وعينا ليُدرك؟
أما الجريدة، فقد جاءت رمزًا مزدوجًا للواقع والزيف، أو للحقيقة المشوهة. حيث كانت حياة البطل مرهونة بثمن الحبر المكتوب عليها، وهو ما يتأكد من رهانه لنفسه: إذا وجد جديدًا في الجريدة سيظل بالبيت، وإن لم يجد فسيخرج إلى المقهى. وعندما وجد جملة "مناقشة أحوال البلاد 2050" تأكد البعد الرمزي لا كعام محدد، بل كتحول فكري ورؤية مستقبلية تتجاوز التنبؤات السطحية.
لقد وُفِّق الكاتب في اختيار الرقم "2050"، إذ يحمل تفكيكه دلالات متعددة:
20: هو المرحلة الانتقالية والرؤية التي لم تُكتمل.
50: هو اكتمال قد يكون نهوضًا أو سقوطًا.
0 : رمز للتوازن ، وربما للّاجدوى.
2: تعبير عن الإزداوجية والحاجة لاتخاذ قرار.
5 : فهو رمز للحركة والتحولات المستمرة.
بهذا يصبح العنوان "2050" مفتاحًا فلسفيًا للسؤال: هل سيكون هذا العام نقطة تحول ونهضة، أم لحظة لا عودة؟
وسط هذه التساؤلات يلفت الكاتب أنظارنا حال البطل عند رؤيته لخبر منزوي في الجريدة عن رجل ألقى بنفسه في النيل. وهنا تنفتح القصة على ثنائية جديدة بين الحقيقة والوهم ، وبين ما يُعرض وما يُخفى .
في هذا السياق، يطرح النص سؤالًا عن الإعلام: هل الإعلام يُشكّل الواقع وفقًا لمصالحه؟ وهل يرى القارئ الحقيقة فعلًا أم يرى ما يُسمح له برؤيته؟
تجلى أيضا الصراع النفسي في صورة أخرى حين يذكر الكاتب أن أوراق الجريدة غطّت البلاط ،حيث يُعد البلاط هنا ( رمزاً للواقع المجرد من التجميل) . ثم يعود البطل ليأخذ بعضاً منها ليلف بها حذاءه الهالك. هنا يتقاطع الواقع المستهلك الممثل في (الحذاء) مع الزيف المؤقت وهو (الجريدة)، ليشكّلا معًا صورة مشوهة ؛ فالزيف لا يستطيع إنقاذ الحقيقة. الحذاء رمز للطريق الذي استُهلك، والجريدة قناع هشّ ينهار أمام ثقل الزمن.
في النهاية، يظل لكل قارئ رؤيته الخاصة؛ فقد يختلف النقاد في فك شفرات النص، وربما يبتعدون عن نوايا الكاتب ليكتشفوا أبعادًا لم يكن يُدركها. وهكذا، تتجاوز قصة "2050" مجرد نص قصصي لتغدو مختبرًا فلسفيًا لفكرة الوعي والزيف ، الانهيار والثبات، والحقيقة والوهم.
لكن، ورغم هذا العمق، تبقى القصة متاحة للقارئ العادي بقراءتها المباشرة، حيث يمكن أن يراها مشهدًا واقعيًا عن بطل غارق في تفاصيل الحياة اليومية، يفتش عن بصيص أمل في جريدة أو في نافذة صغيرة تُطل على الأسفلت. وهذا ما يعكس ذكاء الكاتب: أنه يكتب نصًا يفتح بابًا للتأمل الفلسفي عند الناقد، بينما يمنح القارئ البسيط قصة يمكن أن يتماهى معها بلا عناء.
ومن القصص التي تحمل البعد الفلسفي والرمزي وتفتح مجالًا خصبًا للتأمل والنقد كما ذكرت من قبل هى قصة "الجدران " التي ترسم عزلةً خانقة، حيث تتحول الجدران من حدود مادية إلى رموز للقيود الداخلية، فتغدو مرآةً للخوف والجمود الوجودي ، فتأتي لتفتح بابًا على أسئلة تتجاوز حدود السرد، فهي لا تكتفي بعرض مشهد لإنسان يحاول العبور، بل تغوص في المأزق الوجودي للحرية وما يرافقها من صراع داخلي وخارجي.
الجدار هنا ليس مجرد حاجز مادي، بل إسقاط على كل ما يُقيد الإنسان: الخوف، القوانين، النظرات الاجتماعية ، حتى الروابط العاطفية.
عنوان الجدران يفتح أفقًا فلسفيًا مزدوجًا ؛ فهو من ناحية يحيل إلى الحاجز الملموس الذي يمنع الحركة، ومن ناحية أخرى يرمز إلى الجدران غير المرئية التي يقيمها المجتمع والتاريخ داخل الذات ، فتتحول إلى منظومة من العوائق النفسية والرمزية التي تحاصر الإنسان . هنا ينكشف البعد الوجودي ؛ فالسؤال لم يعد كيف نتجاوز جدارًا ملموسًا، بل كيف نتحرر من جدراننا الداخلية ومن السلطة التي تفرض علينا أن نطلب إذنًا للعبور.
منذ البداية، يُوضع السارد تحت المراقبة ؛ وجوه ونظرات تتحول إلى جدار بشري ، وسلطة تتجلى في صوت يقول: " إذا أردت أن تغادر المكان فعليك أن تطلب الإذن". هذه اللحظة تعيد صياغة الصراع من كونه ماديًا إلى كونه وجوديًا ؛ ليس المهم الجدار ذاته ، بل السؤال ممَن يُطلب الإذن؟؛ أهو المجتمع؟ أم سلطة غيبية؟ أم اللاوعي الذي يُعيد إنتاج الخوف والطاعة؟
عمق النص يتجلى أكثر في مقاطع الصراع الداخلي ، حيث يظهر الرجل الغامض، وكأن حضوره يمثل اللاوعي الجمعي الذي يراقب السارد من الداخل، فيما يرمز الآخرون الذين يريدون الانقضاض إلى المجتمع الجمعي الرافض لكل خروج عن النُسق. عند هذه النقطة يصبح التمرد ليس مجرد فعل جسدي ، بل مواجهة مع طبقات نفسية عميقة ، حيث يتحول العبور إلى صراع داخلي .
وهنا تبرز كلمة الكهنة كبعد فلسفي إضافي ؛ فالجدار لم يعد مجرد عائق اجتماعي أو نفسي، بل صار معبرًا محروسًا بسلطة رمزية تحتكر الحق في السماح أو المنع . الكهنة يمثلون تلك القوى التي تدّعي امتلاك الحقيقة النهائية ، وتجعل الحرية مرهونة بوساطتها، وكأن الإنسان لا يستطيع أن يعبر نحو ذاته إلا عبر مباركة من سلطة أعلى. إن حضور الكهنة يفضح أشكال الوصاية التي لا تنحصر في المجتمع الجمعي أو الروابط العاطفية، بل تمتد إلى مؤسسات تُعيد إنتاج الخوف باسم القداسة والشرعية، وهو ما يفتح سؤالًا فلسفيًا : كيف تتحقق الحرية إذا كان المرور دومًا مشروطًا بسلطةٍ تتوسط بيننا وبين ذواتنا؟
ثم يتصاعد البعد الفلسفي في النهاية، حين يصر السارد: "فحتما لابد أن أعبر الجدران". هنا لا يكون العبور مجرد خطوة للخلاص، بل إعلانًا وجوديًا بالتمرد على السلطة والقوالب . في الوقت ذاته، تُذكِره أطياف الزوجة والابن بمسئوليته العاطفية ، فيتحول حضورهم إلى جدارٍ آخر: جدار العاطفة، الذي يكشف أن الحرية ليست مسألة فردية خالصة ، بل مشروطة بالروابط الإنسانية التي قد تُقيد بقدر ما تمنح المعنى . هكذا يطرح النص سؤالًا أخر : هل الحرية الحقيقية ممكنة ما دمنا محاطين بروابط ومسئوليات؟ وهل نملك أن نتمرد دون أن ندفع ثمنًا عاطفيًا؟
أيضا الألوان كان لها نصيب بالنص " اللون الرمادي " في جملة " الأفق الرمادي " يحمل دلالته الخاصة ؛ فهو ليس بياضًا مطلقًا ولا سوادًا كاملًا، بل مساحة وسطية تجسد حالة التأرجح بين الانفتاح والانغلاق، بين الأمل واليأس. بهذا يصبح الأفق الرمادي مرآة للوجود الإنساني ذاته: لا يقين فيه، بل احتمالات معلقة تنتظر حسم العبور.
في النهاية، لا يترك النص القارئ أمام قصة مغلقة، بل أمام سؤال مفتوح: هل نحن أحرار فعلًا في تجاوز جدراننا، أم أننا محكومون بجدران أكبر من وعينا، تجعلنا مسيّرين أكثر مما نحن مخيرون؟ هنا تكمن قوة الجدران : نحن امام نص قادر على أن يفتح أبواب التأويل .
من هنا يمكن القول إن الكاتب حسام أبو العلا في مجموعته القصصية " صوت من الماضي " قد انحاز إلى الصدق الإنساني أكثر من أي تقنية شكلية، فجاءت نصوصه كمرآة كاشفة لعطب العلاقات وتصدّع القيم في المجتمع، دون أن يتورط في المباشرة الفجة أو التنميط من خلال شخصياته النسائية التي تتحرك في فضاء يسيطر عليه رجال بظلالهم الثقيلة، ومن خلال فضاءات محكومة بالانتظار أو التوتر أو الصراع الداخلي، نجح أن يرسم لوحة واقعية يُداخلها البعد الرمزي والفلسفي.
وهكذا يتضح أن قوة هذه القصص لا تكمن فقط في أحداثها أو حبكاتها، بل في جرأتها على طرح الأسئلة ، وصدقها في ملامسة ما يتوارى خلف الجدران ، حيث يبدأ الصراع الحقيقي في اعماقنا .
نحن أمام كاتب يملك أدواته يعرف ماذا يريد ؟ يعلم جيداً تأثير الكلمة على القارئ ؛ وقد نجح بالفعل في ذلك .
#نقاش_دوت_نت



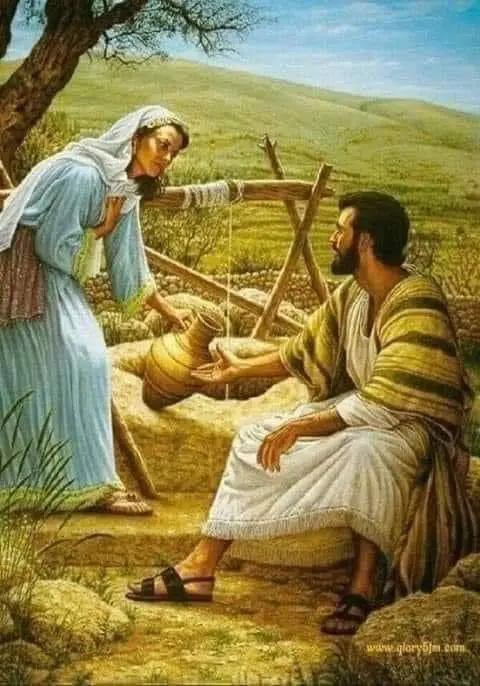




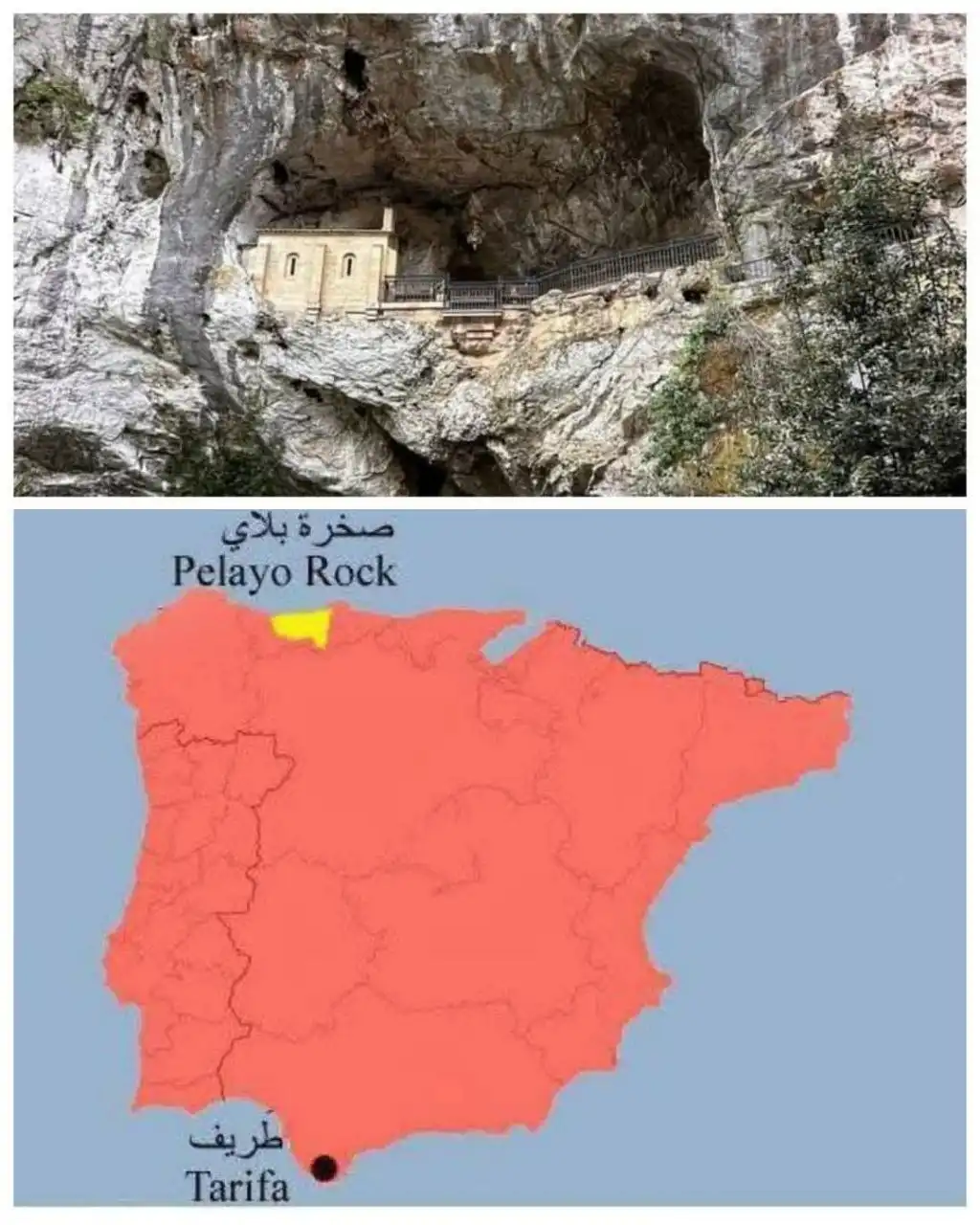















التعليقات
أضف تعليقك