
رؤية ذائقية لقصة "دخان سجائر " للأديبة سلوى بدران
.jpg)
بدأت الكاتبة سلوى بدران قصتها دخان سجائر بوصف الابن وهو يرى وجه أمه من خلال نافذة، وكأنها ليست فتحة في جدار، بل في الزمن ذاته . الأم تغسل الأواني ، لكنها في الحقيقة تغسل أثقال الحياة. رغوة الماء التي تغمر يديها ليست ماءً فقط ومنظف ، بل هي أثر السنوات التي لم تعرف الراحة.
تلك الرغوة هي فقاعة وهم تلمع ثم تختفي تمامًا مثل أحلام بطل قصة اليوم. الابن يطفئ سيجارته على عجل، يخفيها، وكأنه يخفي جزءًا من حياته التي لا يريد للأم أن تراه. أراد أن يخفي اللون الرمادي من حياته، حيث يمثل الوجود بين عالمين: الواقع والأمنية. فكل ما بينهما قائم على الستر والصمت والحب الذي لا يحتاج إلى كلام.
وهنا تستخدم الكاتبة تقنية الفلاش باك كسقوط تلقائي للزمن داخل النفس لا كعودة متعمدة. الماضي لا يظهر كتذكّر، بل كجزء من الحاضر نفسه. و كأن الذاكرة لم تُستدعَ، بل قفزت بنفسها لتقول إن هذا الماضي لم يذهب .
الفلاش باك هنا ليس سردًا لما كان، بل كشفًا أن ما كان ما زال يعمل داخله، حيًّا، نابضًا، ومؤثرًا في كل حركة.
لقد ركزت الكاتبة على شخصيتي الأم والابن، فجعلت عبء الحياة بالكامل يقع عليهما، وهنا تتكرس ثنائية الألم المشترك: الأم ألم الجسد، والابن ألم الروح.
هذا المكان الذي يقف فيه الآن كان يومًا مسرح أحلامه الأولى. كان يساعد أمه، يرفع السجاد، يتباهى بقوته، لكنه لم يكن يبحث عن مجد مبكر. كان يبحث عن نظرة واحدة من الفتاة التي كانت تعيش خلف بابًا يفصل بين عالم الفقر الضيق، وعالم الاتساع الذي يعجز في الوصول إليه. كان يقف أمامه دائمًا كمن يقف أمام قدس الأقداس — يرى ولا يلمس. حتى حين كان يُسمح له بالدخول، كان دخوله دخول خدمة، لا دخول انتماء أو امتلاك .
باب غرفة الفتاة، رغم رمزيته للعبور، كان يُعلن عن ازدواجية تقيد مصداقيته كان مفتوحًا حين كان طفلًا لأن البراءة هنا تلغي الحدود، لكن عندما أصبح رجلًا صار مغلقًا في وجهه، بل في وجه الحُلم والأمنية.
تمر السنوات . يخرج من الحلم كما يُخرج دخان سيجارته من فمه الذي اعتاد على الصمت ليتبدد . فيتزوج. و ينجب ثلاث بنات يشبهن أمهن — امرأة لا يسميها ولا يصفها، لأنها ليست في نظره إلا وظيفة استمرار الحياة. هكذا تتحول الزوجة إلى وعاء للزمن لا شريكة فيه. ليس لأنها بلا قيمة، بل لأنه ظل معلّقًا بامرأة أخرى، بصورة لا تموت، بصورة تجمّدت على هيئة ذكرى نقية داخل رأسه.
لم أسأل الكاتبة لماذا اختارت رقم ثلاثة ليكون عدد بناته ؟ ! ، إذ ربما اختياره لم يكن مقصودا لكني رأيته موظف فهن يمثلن الماضي والحاضر والمستقبل فهو متعلق بماضيه اى حُلمه ويعيش حاضره رغمًا عنه ويترقب المستقبل في صمت .
اختارتهن بنات يشبهن أمهن ، لأن الذكر امتداد لذاته اما الأنثي تجعل القطيعة مع الحلم مستمرة ، و الشبه هنا ليس في الشكل لكن شبه في التمسك " بشبيه الروح ، الطبقة ، الثقافة ، أو ربما واقعه "
أما عن بناء الشخصيات يستدعي وقفة؛ فشخصية الدكتور وابنته لم تُقدَّما بعمق إنساني واضح، بل ظهرتا فقط من الزاوية التي أراد الراوي تثبيتها، بوصفهما رمزًا لعالم الثراء والاكتمال الذي ظل البطل واقفًا خارجه.
لم يُسمح لنا برؤية دواخل الفتاة، أو هشاشتها، أو حتى تناقضاتها؛ لأنها لم تُكتب بوصفها إنسانة كاملة، بل بوصفها هالة متعالية، حُلمًا صاغه الفقر لا القلب. وكذلك الدكتور؛ لم يظهر كأب أو كإنسان، بل كحدّ طبقي صلب، كبوابة لا تُفتح.
حتى الأب في الجهة الأخرى، فحضوره الجسدي قائم لكنه مشلول المعنى: نائم يشخر. لو كان غائبًا تمامًا لفتح مساحة للتأويل، لكن وجوده على هذا الشكل يجعل الألم أوضح: الأم وحدها، والابن يتشكل في ظل غياب لا يملك حتى عظمة الفقد.
وحين يعود البطل إلى الفيلا بعد زمن طويل، يجد كل شيء كما كان: النباتات خضراء، الجدران مشرقة، المكان لا تعتريه الشيخوخة . الزمن لا يأكل الطبقة المرفهة. الزمن يأكل فقط هؤلاء الذين وقفوا طوال حياتهم على العتبات. يرى الفتاة — الآن امرأة أجمل — ويرى الدكتور وقد غزاه الشيب دون أن يهزمه .
هنا نرى اختلاف الشيخوخة: هناك من يشيخ بكرامة، وهناك من يشيخ انكسارًا.
في تلك اللحظة، لا ينهار، ولا يتكلم، ولا يبكي.
إنه فقط يبتسم.
ابتسامة بلا معنى.
ابتسامة مَن أدرك أن الحياة وضعت كل شيء في مكانه، وأنه لم يكن من أصحاب الأبواب المفتوحة، بل من الواقفين أمامها.
فكانت البوابة ليست بوابة فيلا، بل بوابة طبقة. لقد كان البطل مُدركًا أن لكل عالم قوانينه الخاصة. فهو عالق بين بوابتين: بوابة الفقر التي تطحنه، وبوابة الثراء التي لا تحتفي به.
هكذا تنتهي القصة كما بدأت:
بإنسان يحاول أن يخفي الرماد المتبقي من حلم لم يحترق تمامًا، لكنه لم يعد يشتعل أيضًا.
#نقاش_دوت_نت



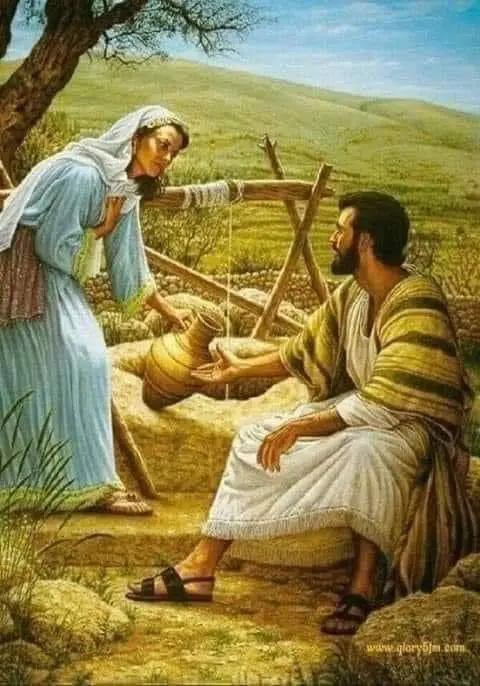




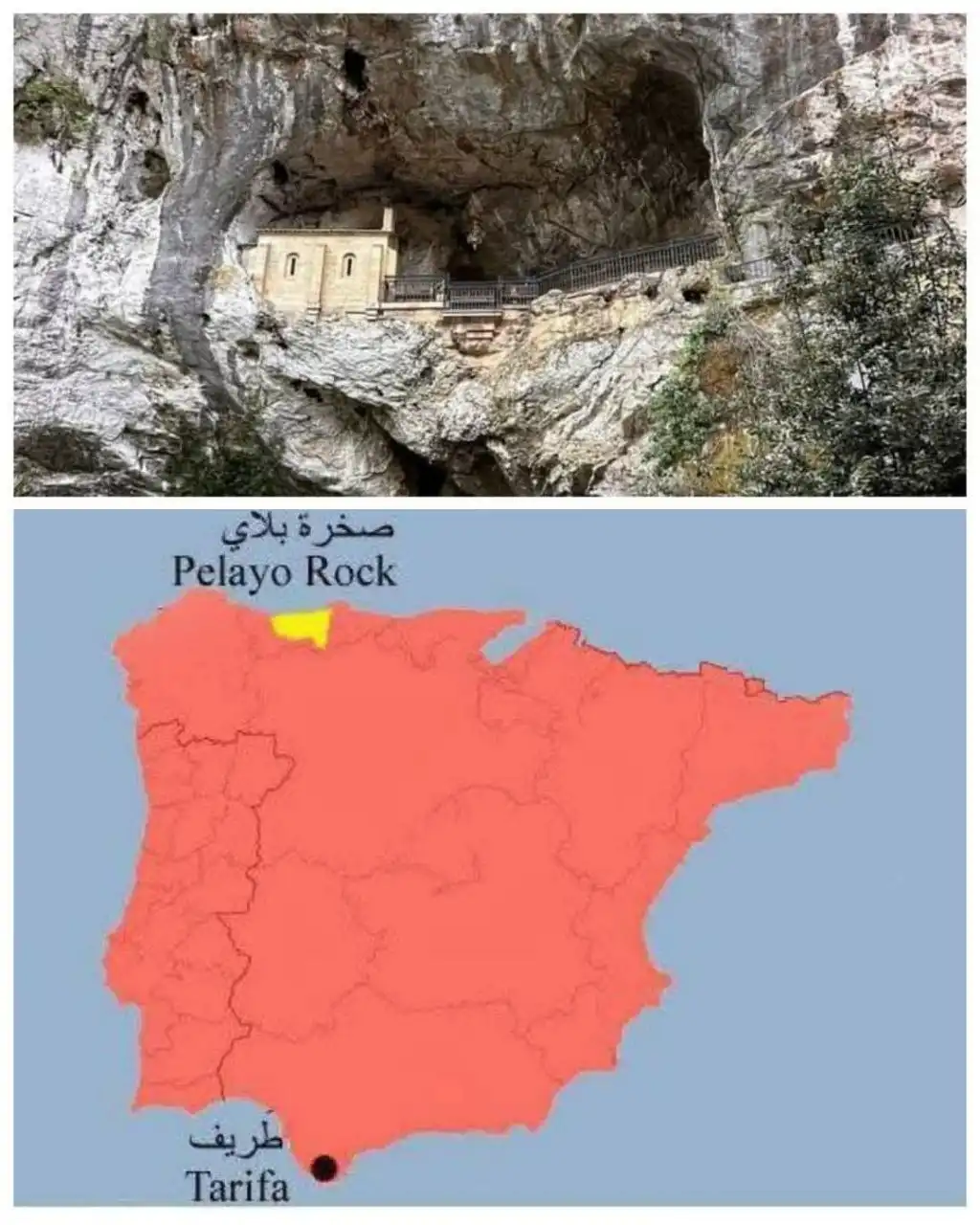















التعليقات
أضف تعليقك