
تطوير النص عند القارئ النموذجي وإشكالية الذكاء الاصطناعي.. قراءة في فكر إمبرتو إيكو

ليست كل النصوص السردية أو الشعرية مغلقة على معناها، كما أنها ليست جميعها مُستباحة أمام التأويل. فبعض النصوص تُكتب وهي تترك الباب موارباً، لا لتُقتحم، بل ليعبُر منه قارئ بعينه، قارئ لا يكتفي بالمتعة الأولى، ولا يتوقف عند السطح الدلالي، بل ينخرط في تفكيك البنية، واستنطاق الإشارات، وتأويل المسكوت عنه. ذلك هو القارئ الذي وصفه إمبرتو إيكو بـ( القارئ النموذجي) ، لا بوصفه قارئاً مثالياً أخلاقياً، بل بوصفه واعياً قادراً على إنجاز ما يسمح به النص نفسه.
وفي لحظة نادرة، قد يبلغ هذا التأويل درجة من العمق والذكاء تجعل كاتب النص ذاته يقف مدهوشاً، كأن النص قد كُتب بيدٍ أخرى حركت جمود النص . هنا لا يُختطف النص من صاحبه، ولا تُفرض عليه قراءة قسرية، بل يُرفَعه ( القارئ النموذجي ) إلى مستوى لم يكن ليبلغه دون هذا التفاعل الخلاق.
غير أن هذه النتيجة لا تتحقق اعتباطاً، ولا تُمنح لكل قارئ، بل تخضع لشروط دقيقة، أشار إليها إيكو صراحة وضمنياً، تتعلق بصفاء الذهن، والتأهيل الفني، والاستعداد العاطفي لحب المادة السردية أو الشعرية ذاتها.
فالصفاء الذهني شرط أولي في عملية التلقي، لأن القراءة فعل وعي قبل أن تكون فعل نظر. ويضرب إمبرتو إيكو مثالاً بسيطاً لكنه بالغ الدلالة حين يتساءل: ماذا لو شاهدت فيلماً كوميدياً وأنت في حالة نفسية يُرثى لها؟ هل ستضحك؟ بالطبع لا. فالنص، مهما بلغت طاقته التعبيرية، لا يعمل في فراغ، بل يتفاعل مع قارئ حاضر ذهنياً، قادر على استقبال إشاراته والانخراط في منطقه الداخلي.
إلى جانب ذلك، يبرز التأهيل الفني بوصفه شرطاً لا غنى عنه. فالقارئ النموذجي ليس قارئاً عادياً، بل قارئاً مدرباً، يمتلك أدوات الفهم، ويعرف تقاليد السرد والشعر، ويميز بين البنية والحدث، وبين اللغة بوصفها حيلة جمالية واللغة بوصفها حاملة للمعنى. هذا التأهيل لا يُحول القراءة إلى تمرين أكاديمي جاف، بل يمنحها عمقها، ويقيها من السقوط في الانطباعية السطحية أو التأويل المنفلت.
أما الشرط الثالث، وربما الأهم، فهو حب المادة المقروءة ذاتها. فالنص لا يهب أسراره لمن يتعامل معه بوصفه واجباً أو استعراضاً ثقافياً، بل لمن يقرأه بشغف حقيقي. الحب هنا ليس عاطفة رومانسية، بل استعداد داخلي للدخول في عالم النص، واحترام منطقه، والصبر على مراوغته. ومن دون هذا الحب، يتحول التفكيك إلى عنف، والتأويل إلى استعراض فارغ يتقنه بعض الأكاديميين أصحاب مصطلحات الطبل الصفيح.
غير أن القارئ النموذجي، وفق هذه الشروط، أصبح اليوم نادر الوجود في ظل عزوف جماعي عن القراءة العميقة، وتراجع مهارات التلقي لصالح الاستهلاك السريع للنصوص. ففي الوطن العربي، يقرأ الفرد في المتوسط أقل من ربع صفحة سنوياً، ويقضي الطفل العربي دقائق معدودة فقط في القراءة الحرة سنوياً أمام الريلز ومشاهدة مقاطع الفيديو .
وفي هذا السياق، بات التأويل الجاد فعلاً يثير الريبة أكثر مما يثير الإعجاب. فعندما يواجه القارئ العادي قراءة تأويلية دقيقة، تفكك النص وتعيد ترتيب إشاراته وتكشف طبقاته الدلالية، لا يُفسر هذا الجهد بوصفه ثمرة وعي وتأهيل، بل يُستقبل بدهشة مشوبة بالشك، كأن هذا العمق لا يمكن أن يصدر عن عقل بشري.
ومن هنا نشأت مفارقة عصرنا: أن يُتهم التأويل العميق لنص شعرى بأنه نتاج ذكاء اصطناعي، لا لأنه آلي، بل لأنه أكثر إنسانية مما اعتاده المتلقي المعاصر. وهنا يبرز "بارادوكس" العمق، إذ يُحاكم العقل البشري المبدع اليوم بمعايير الآلة، فكلما زاد عمق الاستنباط نُزعت عن القارئ صفة ( النباهة) لتُستبدل بصفة ( الخوارزمية ) وكأننا صادرنا حق الإنسان في التفوق والتحليق بعيداً عن السطحية، مفسرين الجودة العالية بأنها (مصنوعة) لا (إبداع).
فالقارئ الذي تمرس على القراءة السطحية، وتربى على النصوص الجاهزة بتمرير سبابته علي شاشة هاتفه ، بات يرى في التحليل المركب ضرباً من ( الألية )، لا فعلاً ثقافياً أصيلاً. وهكذا، لا يصبح الذكاء الاصطناعي هو المتهم الحقيقي، بل الفراغ القرائي الذي جعل العمق استثناءً، والسطح هو القاعدة.
وفي هذا السياق، يمكن استدعاء تحذير إمبرتو إيكو المبكر من موت القارئ المؤهل، لا موت النص ولا المؤلف. فالمشكلة لا تكمن في انفتاح النص، بل في غياب من يملكون مفاتيح هذا الانفتاح. ومع تراجع القارئ النموذجي، يُساء فهم كل قراءة تتجاوز الوصف إلى التأويل، وكل تفكيك يُقرأ باعتباره افتعالاً، وكل جهد معرفي يُنسب إلى آلة، لا إلى عقل تمرن طويلاً على الفهم.
● خاتمة
في زمن تتسارع فيه النصوص وتُختزل فيه القراءة إلى انطباع عابر، لا يبدو القارئ النموذجي ترفاً نقدياً، بل ضرورة ثقافية مُهددة بالانقراض. فالنص، مهما بلغ انفتاحه وثراؤه، يظل معلقاً بين الاحتمال والإنجاز، لا يكتمل إلا بوعي قادر على تفكيكه دون انتهاكه، وتأويله دون مصادرته. وما يُنسب اليوم إلى الذكاء الاصطناعي من دهشة وعمق، ليس في حقيقته إلا انعكاساً لغياب هذا القارئ المؤهل، الذي كان يوماً جزءاً أصيلاً من العملية الإبداعية. وهكذا، لا تكمن أزمة النص المعاصر في كُتابه ولا في أدواته، بل في قارئ لم يعد حاضراً بما يكفي ليُنجز المعنى، ويمنح النص حقه في الحياة.
#نقاش_دوت_نت








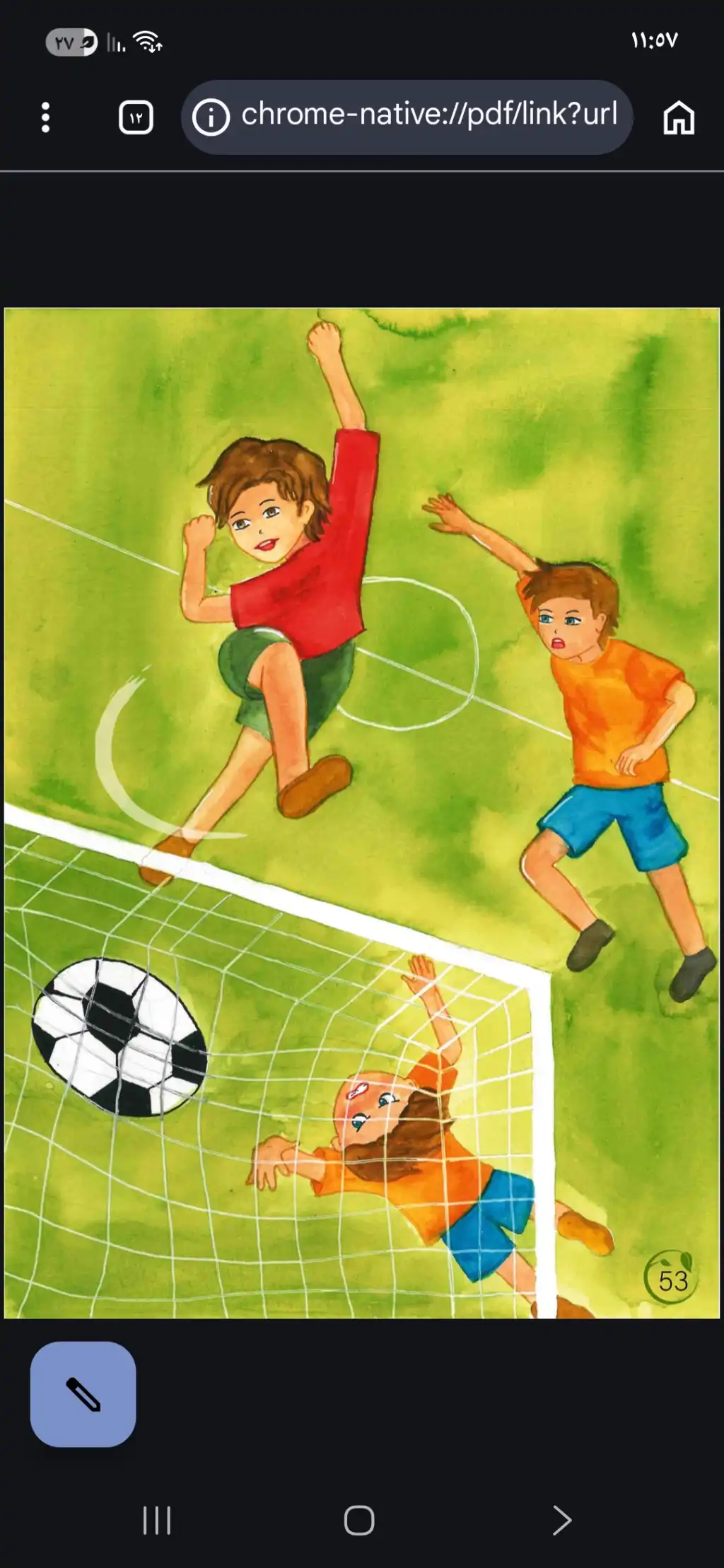
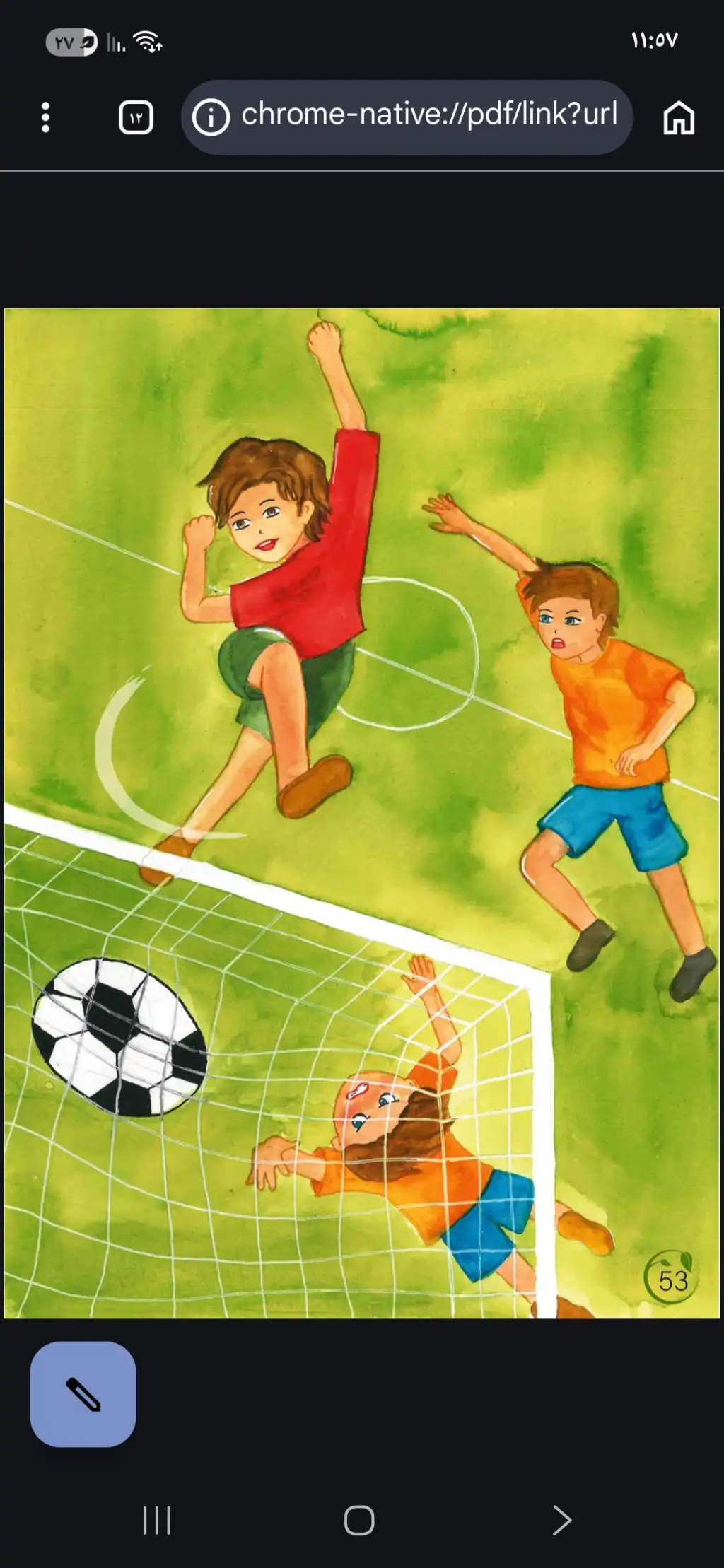



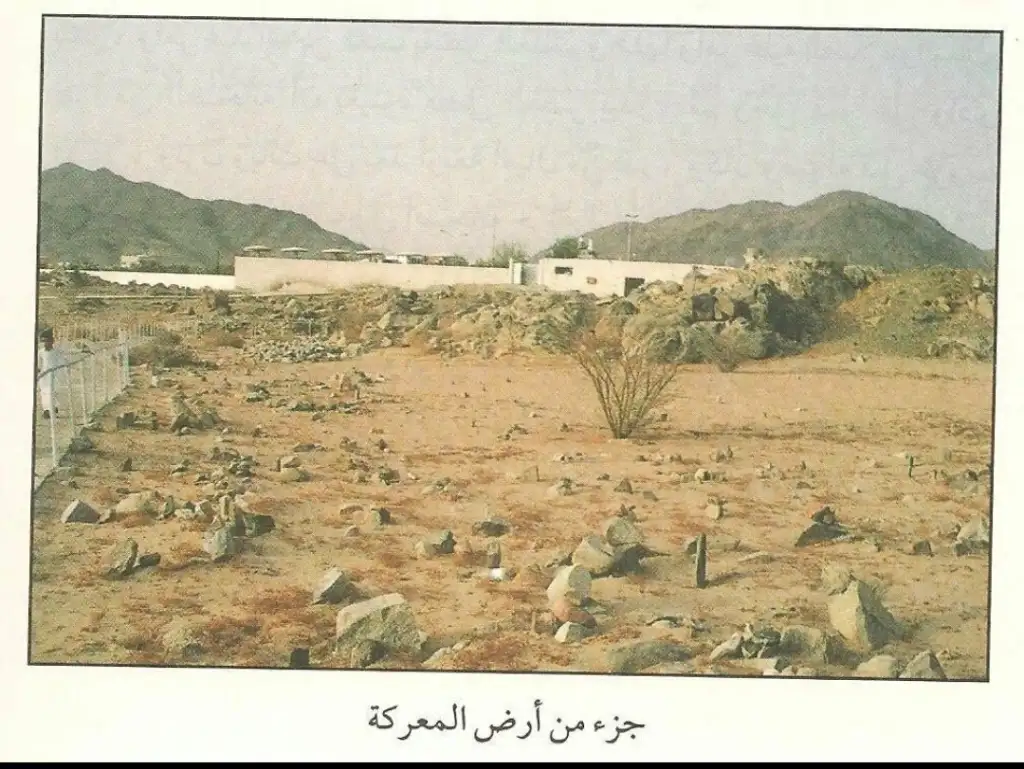



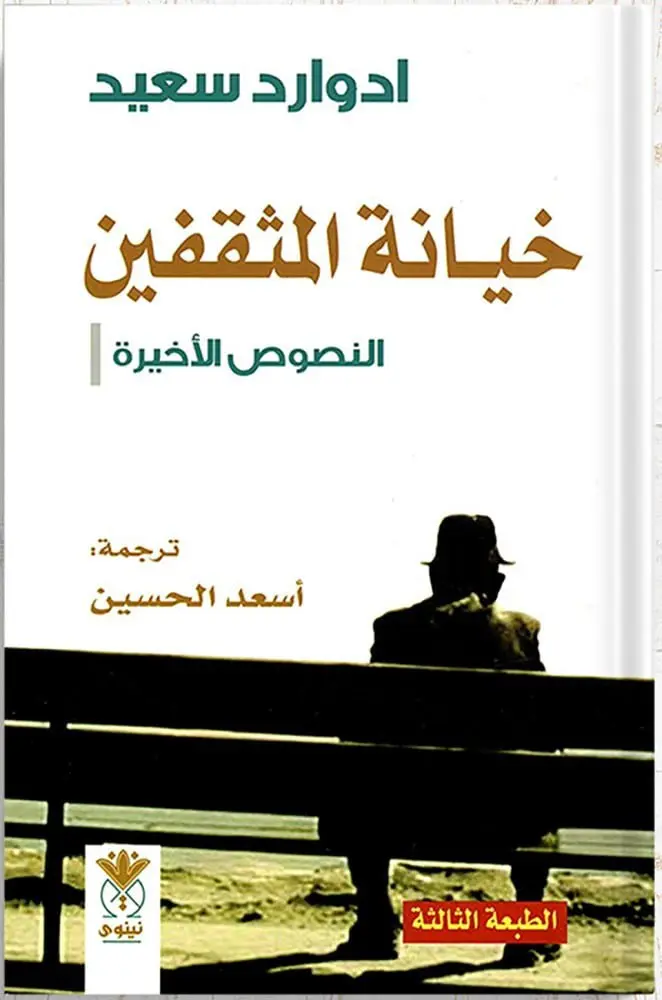




التعليقات
أضف تعليقك