
رؤية ذائقية لقصة " أبي " للأديبة رانية المهدي من المجموعة القصصية "الأسماك يحكمون المدينة "

ما نعرفه أن الأديبة رانية المهدي أنها دائما ما تستخدم في نصوصها الفانتزيا ، إلا انها في هذا النص تنحاز للواقعية الفلسفية ، كاشفة عالمًا حقيقيًا وقد نُزعت اقنعته الرمزية ، لا ليبدو أكثر قسوة فحسب ، بل اكثر صدقًا. ومنذ العتبة الأولي ، يقدم النص عنوانه " أبي " بوصفه فخًا دلاليًا لا وعدًا حميميًا ؛ فالمباشرة هنا ليست إحالة الإلفة ، بل مدخلًا لخلخلتها.
الكلمة ، أو بمعنى أصح العنوان يحمل إرث إنساني ثقيل ، حيث تستدعي معاني الحماية واليقين، إلا ان السرد يتعمد تفريغ هذا النداء من مضمونه، ليضع القارئ أمام مفارقة جوهرية ، أب حاضر بوصفه خطابًا ومكانة، وغائب بوصفه علاقة .
هكذا يتحول العنوان من تثبيت لمعنى الأبوة إلى مُساءلة فلسفية لها: فالأب ليس أصل الطمأنينة ، بل مركز السلطة ومنصبًا رمزيًا يورث لمن يمتلك أدوات التأثير والإقناع. ومن هنا لا يعود " الأب" شخصًا بقدر ما يصبح موقعًا، ولا تعود الأبوة علاقة دم، بل دورًا يعاد إنتاجه، حتى بعد الموت.

النص هنا لا يبدأ من سؤال الموت، بل من سؤال أعمق: ماذا يحدث حين يفشل الإنسان في أن يكون ما يُنتظر منه، ثم يترك وراءه أثرًا أقوى من حضوره؟ هنا لا يعني الموت النهاية ، بل يتحول إلى أداة إعادة توزيع وإلى لحظة يٌستعاد فيها ما لم يُعش، ويُنتزع فيها ما لم يُمنح. النص لايرثي الأب، بل يضعه موضع مُساءلة وجودية: هل القيمة فيما نكونه، ام فيما يمكن للآخرين أن يصنعوه منا بعد الغياب؟
من هذا المنطلق لا يتعامل النص مع الموت بوصفه فاجعة أخلاقية او لحظة رثاء، بل يقدمه كمساحة متأخرة للاستثمار، كفرصة اخيرة لانتزاع ما فشل في التحقق خلال الحياة. الأب الذي لم ينجح في أداء معنى الأبوة، ولم يقدم ذاته كعلاقة حقيقية، يتحول بعد موته إلى رأسمال رمزي قابل لإعادة و التشكيل. الموت هنا لا يُنهي الحساب، بل يفتحه، ويمنح مَن حوله سلطة لم تكن متاحة في حضوره.
الأب في هذا النص ليس جوهرًا أبويًا، بل دورًا شاغرًا أُدى بسطحية ، أولى السرقات وقعت في حياته، حين استولى على موقع الأب دون أن يمنح معناه. سرق من الابنة حقها في الحنان، وترك لها بدلًا منه إرثًا لغويًا وشهرة وقلمًا مثقلًا. لم يمنحها ذاته، بل منحها أداة ، وكأن الأبوة أُرجئت إلى ما بعد الموت، لا لتُعاش، بل لتُكتب .
الكتاب التي صاغته الأبنة عن حنان الأب التي تمنته كأنه واقع عاشته بدأ بالقلم، وهذه ليست مصادفة بنيوية بل إعلان فلسفي عن موضع السلطة. القلم أداة فردية حميمية ، مرتبطة باليد والعزلة، وبالذات وهى تواجه نقصها دون وسيط. الكتابة بالقلم فعل سيادي لا ينتظر اعترافًا، ولا يحتاج إلى إقناع أحد.
الصديق،على خلاف القراءة السطحية ، لا يغادر الأب خيانة بالضرورة، بل انسحابًا. انسحاب من صورة أدرك زيفها مبكرًا.
حين يصف الأب بأنه سارق ومدعٍ، فإن النص لا يكذبه، بل يلمح إلى وعى لم يُحتمل، فاختار صاحبه الابتعاد. غير أن هذا الوعي ظل ناقصًا، لانه لم يتحول إلى موقف نهائي، بل تجمد حتى لحظة الموت. الصديق الذي رفض الأب حيًا لأنه زائف، عاد إليه ميتًا لأنه صار قابلًا للتوظيف. المفارقة انه لم يكذب في إدراكه الأول، لكنه كذب في استثماره الأخير.
اللحظة الحاسمة في هذا المسار تتجسد في جملة:
" الفصل الاخير في الكتاب ، أحكِ كيف كنت جانبه.. فأنت رمز الوفاء في كتابي "
هذه الجملة لا تعمل كطلب، بل كفعل إقناع كامل . الابنة لا تجادل، ولا تدافع عن سرديتها بأن الأب غمرها بالحنان ، بل تفعل ما كان الأب يفعله مع قرائه؛ تخلق موقعًا رمزيًا ثم تدعو الآخر لاحتلاله. الإقناع هنا لا يقوم على الحُجة، بل على إغراء الدور. مَن يُمنح مكانًا داخل النص، يُغرى بالتخلي عن الحقيقة مقابل الانتماء إلى السرد.
بهذا المعنى ، لا تكون الابنة قد ورثت القلم فقط، بل ورثت وظيفة الإقناع ذاتها. الأب كان مشهورا بقدرته على التأثير في قرائه، لا بالضرورة بصدق ما يكتب، والابنة تسلك المسارذاته دون إعلان.
السلطة هنا ليست أخلاقية ولا شخصية ، بل بنيوية: مَن يصل إلى موضع الكتابة يحتل تلقائيًا موضع التأثير. المكان نفسه يفرض منطقه، بغض النظر عمَن يجلس فيه.
جملة " نظر الصديق طويلًا ثم أخذ الكتاب وانصرف" هذه ليست لحظة تردد، بل لحظة خضوع للسرد. لقد أدرك ـ بوعي أو بدونه ـ أن رفض الدور يعني الخروج من التاريخ، بينما قبوله يمنحه بقاءً رمزيًا، حتى لو كان زائفًا. هنا لا يعود الصديق سارقًا للأب، بل مسروقًا من النص، وقد تخلى عن وعيه القديم مقابل صورة اخلاقية جديدة صُنعت له.
ظهوره لاحقًا قارئًا للكتاب عبر التلفاز يغلق الدائرة، فالنص لا ينتهي عند القلم ولا الصفحة الاخيرة، بل ينتقل من الخاص إلى العام، التلفاز هنا ليس وسيطًا محايدًا، بل سلطة تصديق. ما كُتب بالقلم يمكن الشك فيه، لكن ما يُبث على الشاشة يتحول إلى حقيقة اجتماعية لا تسأل عن أصلها. الشاشة لا تبحث في الماضي، بل تكتفي بالصورة والصوت والنص المقروء، فتغلق باب الشك وتفرض تأويلًا واحدًا.
أما الابنة ، فهى السارقة الأكثر وعيًا والأكثر خطورة . سرقتها لا تأتي بدافع التزييف ولا بدافع التعويض وحده، بل بدافع إدراك أن ما لم يُمنح لا يُستعاد إلا بالانتزاع. هى تسرق من وفاة الأب صورة الأب الذي لم تعشه، وتسرق من مهنته سلطة التاثير، ثم تطلق هذا المعنى إلى المجال العام مدركة انها بذلك تفقد السيطرة عليه. لقد بدأت بالقلم حيث السيادة الفردية ، وانتهت بالتلفاز حيث لا يعود المعنى ملكًا لاحد.
من هذا المنظور، لا يُدين النص السرقة ولا يُبررها، بل يكشفها كقانون وجودي. ما لم يتحقق في الحياة يُنتزع بالموت، وما يُحجب عاطفيًا يُستعاد سرديًا، وما يفشل الإنسان أن يكونه، قد يفرض عليه حين يُكتب عنه ويقنع الآخرين. الذاكرة ليست فضاءً أخلاقيًا نقيًا، بل ساحة صراع بين القلم والشاشة ، بين مَن يخلق المعنى ومَن يمنحه الشرعية.
في الخاتمة، لا يعود السؤال: مَن كان الأب حقًا؟ بل: مَن نسمح له أن يكونه بعد موته؟ فحين ينتقل المعنى من القلم إلى التلفاز، ومن الفرد إلى الجماعة، لا تبقى الحقيقة مسألة صدق،بل مسألة تصديق. النص لا ينتهي بإجابة، بل بقلق فلسفي مفتوح: ربما لا يملك الإنسان حياته كاملة ، لكنه ــ إذا كُتب عنه بما يكفي ــ قد يُمتلك بالكامل بعد موته .
#نقاش_دوت_نت



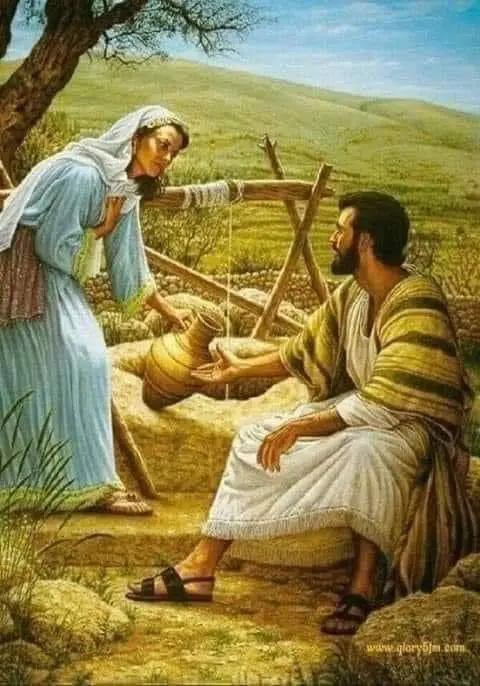




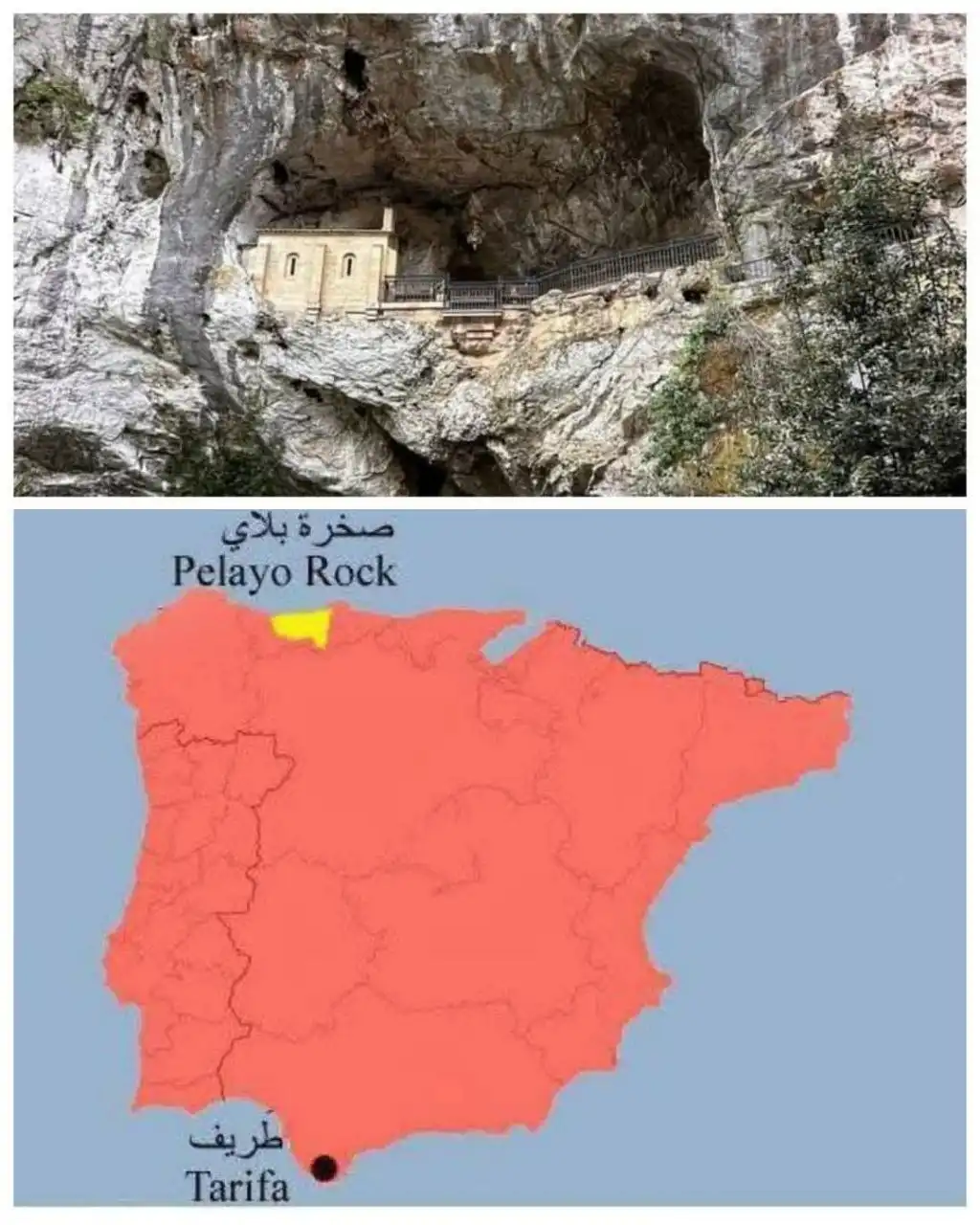















التعليقات
أضف تعليقك