
حين تسرق الكاميرا الحكاية من الديكوباج المحفز إلى الاستعراض التقني

هناك نوع من المشاهد يترك المتفرج منبهرًا. يخرج وهو يتذكر حركة كاميرا واحدة، أو لونًا واحدًا، أو لقطة طويلة واحدة… ولا يتذكر ما الذي تغير فعلًا بين الشخصيات خلالها. يمر الزمن داخل المشهد كاملًا، لكن التحول لا يمر. مما يوحي بأن الفيلم ربح “اللقطة” وخسر “اللحظة”. ومن هذه المفارقة يبدأ الكلام عن السينما حين يصبح الاستعراض التقني بديلًا عن السرد البصري.
هنا لا تكون المشكلة في التقنية، فالسينما أصلًا فن صنع من الضوء والاختراع. المشكلة تظهر عندما تتحول أدوات اللغة السينمائية من وسائل لصناعة التوتر إلى واجهة تعرض المهارة. فتصبح اللقطة “حدثًا” لأنها لقطة، وليس لأنها تدفع الأحداث خطوة للأمام. يصبح الأسلوب علامة مستقلة، مثل توقيع كبير في نهاية لوحة، يلفت العين أكثر مما تفعله اللوحة نفسها.
لا تحتاج السينما القوية أن تقلل من جمالها لكي تكون صادقة. تحتاج فقط إلى “اقتصاد” يجعل كل اختيار له دافع داخل الحكاية. الاقتصاد يعني أن الميزانسين (mise-en-scène)، والديكوباج (découpage)، والمونتاج، وتصميم الصوت تعمل كلها كأعضاء في جسد واحد. كل عنصر له وظيفة، وكل سينوغرافيا لها سبب.
عندما يعمل الاقتصاد السمعي البصري يصبح الأسلوب جزءًا من الفعل نفسه، وفي المشاهد التي تمسك المتفرج حقًا يبدو الكادر كما لو كان يفكر، فالمسافة بين الشخصيتين تقول الكثير قبل أي جملة، وموضع الإضاءة يفضح خوفًا أو يلمح لسلطة، وحركة الكاميرا تلاحق توترًا داخل اللحظة، والمونتاج يضغط الزمن أو يفتحه بحسب ما يحتاجه الحدث، والصوت يبني طبقة شعورية تتشكل بالتأكيد أحيانًا وبالمفارقة أحيانًا وبالصمت أحيانًا، وعندما تتوازن هذه العناصر يبدو أن الفيلم يقترب، وتصبح كل لقطة خطوة محسوبة داخل طريق حتى لو كان الطريق متعرجًا.
عندما تصبح الكاميرا “بطلة” وتزيح البشر يحدث ذلك بسبب عادة تتكرر حتى يتحول الأسلوب إلى شخصية مستقلة، فاللقطة الطويلة مثلًا قادرة على صنع ضغط هائل لأنها تمنع الهروب وتجبر الزمن على أن يعاش كاملًا، لكن قوتها تتراجع حين تتحول إلى فقرة مهارية مكتفية بذاتها، زمن ممتد وحركة ناعمة ومسارات ممثلين دقيقة مع ثبات الجوهر، فتغدو براعة التنفيذ بديلًا عن تحول الصراع، ولهذا تبدو اللقطة المتصلة في Birdman و1917 خيارًا أسلوبيًا كبيرًا لا يثبت معناه إلا بقدر ما يتغير الضغط داخل هذا الاتصال، وينطبق الأمر على التراكينج والستيدي كام حين ينجحان في ترجمة مطاردة أو مراقبة أو اختلال في ميزان القوة، ثم يتحولان إلى ديكور إذا حافظا على النبرة نفسها طوال الوقت من نعومة دائمة وانسياب دائم، بينما المشهد يحتاج أحيانًا ارتطامًا أو تعثرًا أو توقفًا أو فراغًا، فتختفي المفاجأة تحت طبقة من الانسياب، وكذلك عمق الميدان والراك فوكس حين يستعملان كأدوات سرد تنقل الانتباه إلى خطر أو تغير مركز المعرفة داخل اللقطة ثم ينحدران إلى استعراض إذا تكررا بوصفهما حيلة جميلة بلا أثر درامي، ويحدث الشيء نفسه مع التلوين حين يخلق هوية بصرية ثابتة لا تتحول مع تحول الحكاية فيبدو أن الفيلم يعيش على “مظهر” أكثر من عيشه على انتقالات داخلية، فيصير اللون قشرة، ومع الموسيقى حين تكون قادرة على رفع المشهد بصنع طبقة إضافية أو مفارقة أو توتر مضاد للصورة ثم تتحول إلى عكاز إذا تولت إنتاج الإحساس بدل أن ينتجه الفعل، فيصبح الانفعال قرارًا موسيقيًا لا نتيجة ضغط تعيشه الشخصيات.
تظهر العلامات بوضوح في الديكوباج والمونتاج، وهنا تبدأ الحكاية تفقد تماسكها من الداخل حتى لو ظل شكلها مبهرًا، لأن الديكوباج في جوهره هو منطق للمشهد، ترتيب للقطات والزوايا والحركات بوصفه طريقة لقيادة الضغط، وعندما يكون محفزًا يبدو كل قرار كما لو أنه جاء في وقته وله سببه، أما حين يغيب السبب تتحول الزوايا إلى مجرد تنويع، والتقطيع إلى “نمط” ثابت، ويتغير القرب والبعد لأن التغيير جميل لا لأن ميزان القوى تحرك أو لأن الخطر اقترب، ثم يأتي دور المونتاج الذي يفترض أن يبني علاقات بين الأشياء، سببًا ونتيجة، تأخيرًا ومفاجأة، تسارعًا واختناقًا، لكنه في سينما الاستعراض يصبح طلاء لامعًا يخبئ الفراغ بدل أن يصنع ضرورة، فيبدو الإيقاع خارجيًا، ويحاول إقناع المتفرج بالحيوية بينما المشهد نفسه لا يتحرك بما يكفي، ويضاف إلى ذلك بلوكينج يرسم هندسة جميلة داخل الكادر ثم يترك العلاقات كما هي، فيصير ترتيب الأجساد في الفضاء مشغولًا بالزخرفة أكثر من انشغاله بكشف رغبة أو عائق أو انكسار.
وعند هذه النقطة يتغير ما يحدث للمتفرج، لأن التلقي يتبدل من انجذاب إلى الداخل إلى وقوف في الخارج، يظل الإعجاب حاضرًا لكنه إعجاب تقني وليس انخراطًا، ومع تكرار الاستعراض بنفس النبرة يظهر نوع من الإرهاق الهادئ، كل شيء جميل وكل شيء متقَن لكن كل شيء يقول الشيء نفسه، وهنا تفقد السينما جزءًا من مخاطرتها لأن المخاطرة تكون في هشاشة اللحظة الإنسانية وفي قدرة الصورة على ترك أثر لا يختزل في جمالها.
وحين يعود الأسلوب إلى مكانه الطبيعي لا يحتاج أن يختفي بقدر ما يحتاج أن يعود إلى الخدمة، فتغدو حركة الكاميرا امتدادًا لصراع، ويتحول اللون والإضاءة مع التحول بدل أن يثبتا كفلتر، ويستعيد المونتاج وظيفته في بناء العلاقات وصنع الضغط بدل اللمعان، ويعمل الصوت على فتح مساحة معنى لا على ضمان الانفعال، وتظل اللقطة جميلة لكن جمالها يصبح جزءًا من الضرورة.
في النهاية، الفيلم الذي يبقى في الذاكرة يفعل ذلك لأنه يحسن توزيع الطاقة بين الصنعة والنبض. التقنية تصبح أجمل عندما تكف عن الإعلان عن نفسها، وتبدأ في العمل بصمت داخل الحكاية. فعندما يتقدم الأسلوب على البشر، تلمع الصورة وتبهت الحياة. وعندما يعود الأسلوب إلى مكانه الطبيعي، تصبح اللقطة فعلًا داخل العمل، ويعود الفيلم إلى جوهره البسيط، ضوء يرتب الزمن كي نصدق لحظة إنسانية.
#نقاش_دوت_نت



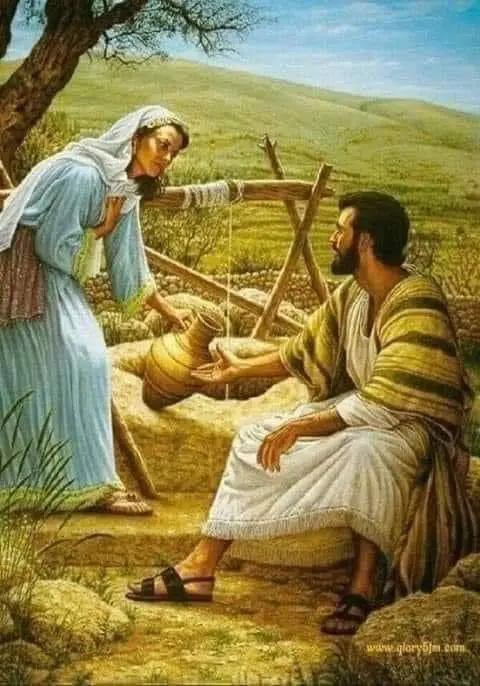




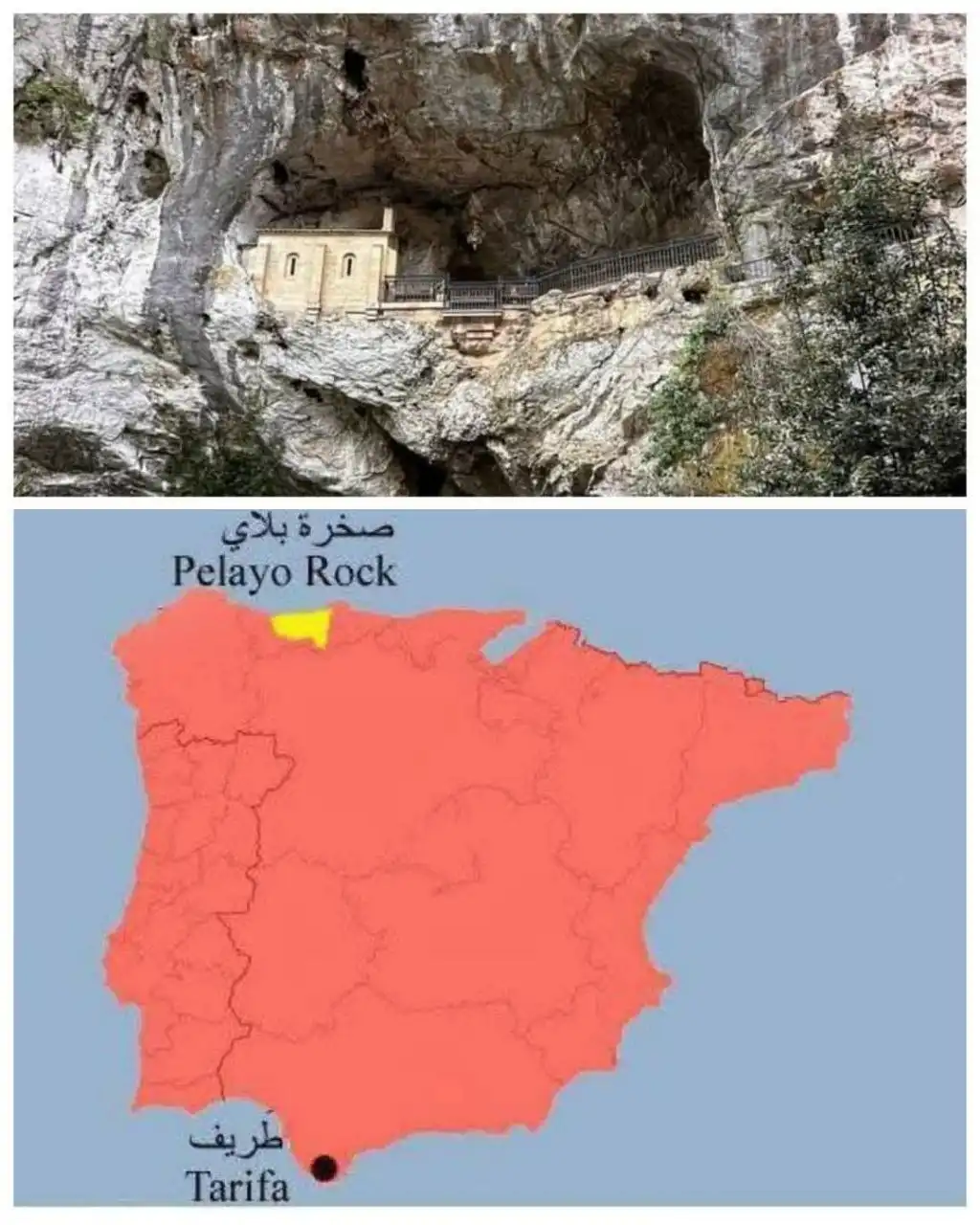















التعليقات
أضف تعليقك